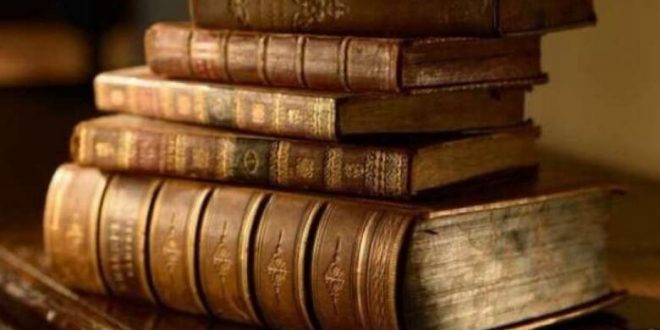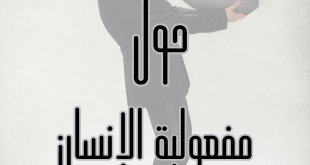من يتأمل القرآن الكريم يجد أن الجذر ع-ل-م ومشتقاته قد تكرر مئات المرات؛ فالله سبحانه وتعالى هو. العليم عالم الغيب والشهادة، لذا نجد مفهوم العلم في الذكر الحكيم رحبًا، حيث يشمل الكون بما فيه من طبيعة وإنسان. وقد ربط القرآن بين العلم والتقوى فأضفى على المعرفة بعدًا غائيًا أخلاقيًا، كما في قوله تعالى في سورة البقرة:” وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”. أما في عصرنا هذا، ومع رسملة العلم وارتباطه بالسوق والتسويق، أصبح الباحث ملزَمًا بالبحث في مجالات تدرّ الربح على جهات التمويل، حتى لو كانت لديه بحوث أكثر نفعًا للناس. وقد ربط القرآن الكريم بين العلم ونفع الناس، كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: “وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ “. ونرى اليوم كيف تُستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إهلاك الحرث والنسل.
ما إذا بحثنا عن مفهوم العلم في التراث الفقهي أو الأصولي أو الحديثي، نجد أن نطاقه قد انكمش نسبيًا؛ فعلى الرغم من أن الحضارة العربية الإسلامية قد زخرت بشتى أنواع العلوم – من طب وفلك ورياضيات وفلسفة وغيرها – فإن بعض المؤلفات التراثية، مثل كتاب: جامع بيان العلم لابن عبد البر الأندلسي (القرن الثالث الهجري) أو تقييد العلم للخطيب البغدادي (القرن الرابع الهجري) -والعلم في هذا السياق المقصود به علم رواية الحديث،- قصرت مدلول العلم على علم الحديث. بل إن بعض العلماء كان يقول العلم: “هو قال الله وقال الرسول”، فحُصرت المعرفة في نصوص القرآن والحديث حصرا.
مع ذلك، فإن القرآن والسنة – كتطبيق عملي له – حثّا على النظر في الكون والتأمل في سنن التاريخ في قيام وزوال الأمم، ودعوا إلى التدبر في آيات الكون. لذا نلحظ هذا التباين بين سعة مفهوم العلم في القرآن وضيق مفهومه في بعض مراحل التراث، خاصة مع تقادم الزمن. ومن العجيب أن القرآن الكريم يقول في سورة العنكبوت: ” قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.
فالقرآن يحثّ المؤمنين على البحث في الكون وكيفية بدايته، رغم أنه قدّم صورة مجملة عن خلق الكون والهدف من الخلق. والمضحك المبكي أن كثيرًا من النظريات المتعلقة بنشأة الكون – مثل نظرية الانفجار العظيم التي توصل إليها الرياضي الفلكي البلجيكي جورج لومتر، وهو كاهن كاثوليكي بجامعة لوفن – جاءت من علماء غربيين، بينما كان في تاريخنا علماء كبار مثل ابن الشاطر الفلكي والميقاتي والمؤذن، وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل هارفي بقرون، وكان فقيهًا شافعيًا، وابن رشد الذي جمع بين الفلسفة والفقه، ولسان الدين بن الخطيب الذي كشف عن كيفية انتشار عدوى الطاعون وكان عالمًا موسوعيًا وسياسيًا بارعًا.
لكن الحضارة الإسلامية بدأت تتراجع علميًا تدريجيًا منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وتوقفت عجلة الإبداع العلمي تمامًا في القرن السابع عشر، وهو قرن الثورة العلمية التجريبية في أوروبا، التي تأسست وتطورت على أيدي علماء مسلمين مثل الحسن بن الهيثم وابن الجزري وغيرهم، ممن صححوا وأضافوا إلى النظريات اليونانية. أوروبا تلقفت علوم العرب والمسلمين من خلال مراكز الالتقاء الثقافي في البحر المتوسط، ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم؛ بل ما كانت الثورة الرقمية لتكون لولا اختراع الحاسوب القائم على علوم الجبر التي وضع أسسها الخوارزمي، الذي استلهم من القرآن الكريم فكرة حل مسائل الميراث.
وحين انحرفت أمتنا عن المفهوم الرحب للعلم في القرآن الكريم، وأعرضت عن الجمع بين القراءتين – قراءة الوحي وقراءة الكون، حسب تعبير الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله ــ، اختل التوازن. فقد كان يقول: “قراءة الوحي دون الكون تؤدي إلى الفكر اللاهوتي الكهنوتي الاستلابي، بينما التفاعل بين النص والكون يولّد الإبداع”. فالكون المسخّر للإنسان المستخلف المأمور بعمارته لا يمكن أن يُعمر دون علم. وفي المقابل، فإن البحث في علوم الكون والمادة بمعزل عن الوحي يؤدي إلى المادية الجافة المنفصلة عن القيم، والتي قد تنحرف عن الغاية الأخلاقية من الخلق: أي العمران وإقامة العدل.
خلال عصور التراجع، ظهر تياران بارزان: التيار الصوفي الغنوصي الذي تأثر بالأفلاطونية، ورأى أن العلم يُنال بالكشف والتواصل المباشر مع الخالق، حتى يبث العلم والحكمة مباشرة في الولي أو القطب. أما التيار الثاني تيار أهل الحديث حصر العلم في النصوص، سواء أكانت أحاديث مرفوعة للنبي ﷺ أو موقوفة على الصحابة، ورأى أن هذه النصوص توفر الحل النهائي لكل المشكلات المعرفية ، وللأسف أصبح العالم الإسلامي كطالب نابغ في سنوات دراسته الأولى ثم توقف في المرحلة الثانوية ولم يكمل مسيرته التعليمية. الحروب، وعدم الاستقرار السياسي، وخسارة طرق التجارة الكبرى لصالح القوى البحرية الأوروبية (إنجلترا، إسبانيا، البرتغال) في القرنين لخامس عشر والسادس عشر، كلها كان لها أثر مدمرعلى العالم المسلماني.
ظل الحفظ والتلقين والنقل الشفوي هي السمة الغالبة، وأُهمل التفكير النقدي والتجريبي. المنطق الأرسطي قيد العقل بالقياس اللفظي والاستنباط، فجعل التعليم الشرعي منفصلاً عن الواقع. هذا دفع الدولة العثمانية إلى استيراد التعليم الأجنبي أو إرسال البعثات، بدل إصلاح النظام التقليدي او ابداع نظم جديدة تلبي حاجات العصر. ومع دخول التعليم الغربي في القرن التاسع عشر، فقد العالم الإسلامي شخصيته التعليمية والفكرية. بل تسبب التعليم الوافد الذي خلق نخبة جديدة دخلت في صراع مع ابناء التعليم التقليدي، الذي كان يمثل النخبة القديمة التي ستفقد امتيازتها الاقتصادية والعلمية والاجتماعية مع الوقت، و تسبب هذا الأمر في صدع وشقاق فكري واجتماعي في المجتمع المسلم وظهرت الثنائيات الفصامية : الصراع بين الأصالة والمعاصرة. و كال كل فريق الاتهامات للفريق الأخر فأبناء المدارس الحديثة يصفون ابناء التعليم التقليدي بالرجعية والتخلف؛ بينما نعت التراثيون الحداثيين بالمستلبين تقافيا بل بالعمالة للمحتل وربما وصل الأمر للتكفير!
كما فشلنا في مأسسة العلم؛ فالطالب يتخرج ويُجاز من شيخ لا من مؤسسة، والشيخ كثيرًا ما يقيس نفسه على الرسول ﷺ قياسًا فاسدًا، فيربي الطالب على المعرفة المنقولة بالسند دون تشجيعه على التفكير المستقل. هذه المنظومة أنتجت أشخاصًا قابلين للاستبداد والاحتلال، حتى كان الحل في استيراد نظم التعليم الغربية، بدءًا من المدارس التبشيرية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الجامعات الأجنبية في القرن العشرين.
خلاصة القول حين انحرفت الأمة عن المفهوم القرآني الرحب للعلم، الذي يشمل العلم بالخالق والمخلوق معًا، فقدت توازنها العقلي والروحي، وانفصل المعرفي عن الأخلاقي. حُصر مفهوم العلم وفق التعريف الغربي بأنه كل ما يخضع للتجربة، فاستُبعد الوحي، وضاعت الرؤية الكلية للقرآن في تنظيم علاقة الله بالإنسان والطبيعة. النتيجة: علم في خدمة رأس المال، وطبيعة ملوثة، ومناخ مختل، وأزمات أخلاقية. والسؤال: كيف نستفيد من تجربتنا التراثية الطويلة وفق منهج نقدي؟ وكيف نعيد بناء منظومة معرفية وتعليمية وتربوية تتجنب هذه المشكلات؟
بقلم د \أحمد أمير
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد