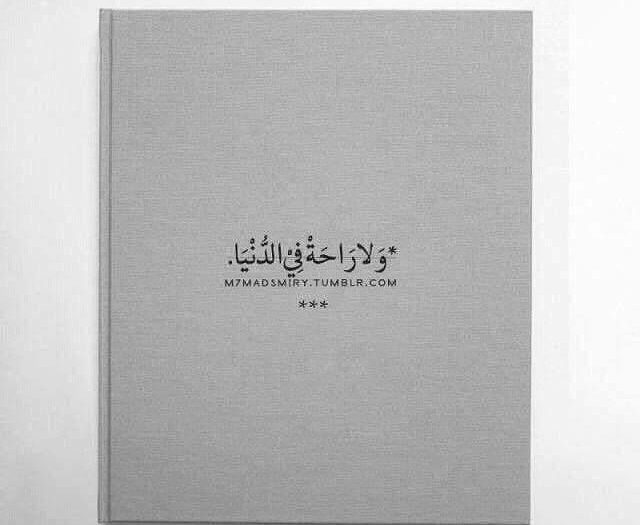موضوعنا اليوم يتعلق بجملة شهيرة وردت في أحد الأحاديث الموضوعة, والجملة صحيحة المعنى, وهي
لا راحة في الدنيا!
وهي من الجمل التي ينبغي أن تكون أصلا من أصول التربية, التي تُلقن للصغار وتفهم للكبار على حد سواء! حتى يتخلقوا بها تمام التخلق!
ولو آمن الناس بهذه الحكمة, لتغير حالهم وسعيهم في هذه الدنيا كثيرا! والعجيب أن كثيرا من المسلمين يكررون هذه الجملة في المواقف المناسبة لها, إلا أنهم لا يؤمنون بها أو يتحركون له!
ومظاهر وأسباب عدم الراحة في الدنيا كثيرة, وسنتكلم عن بعضها وأشهرها:
الناظر في أحوال عامة البشر, مسلمين كانوا أو غير مسلمين, يجد أن جل سعيهم من أجل الراحة!
فهو يعمل ويجتهد في العمل من أجل أن يؤمن مستقبل جيد لنفسه يرتاح فيه من العمل! أو يجد دخلا طيبا يستطيع أن يؤمن به لنفسه فترات من الراحة في أجازات من العمل, ينفق فيها ببذخ!
أو يكدح ويوفر من أجل أن يوفر مستقبل راغد لابنه, بحيث لا يجد نفسه مضطرا إلى الكدح والشقاء, فيكون ممن ولدوا وفي أفواههم مغارف –وليست ملاعق- من ذهب!!
ولا حرج ولا إشكال في أن يبحث الإنسان عن الثراء المادي, ولكن الحرج والإشكال كله في توجيه الإنسان لفكره ولسعيه!
وبسبب هذه التوجيه الخاطئ الباحث عن الراحة, لا يرتاح الإنسان في الدنيا, ولو آمن أنه مخلوق في كبد ليكدح لارتاح باله! وراحة البال أهم من راحة الجسد!
فلو آمن بما قاله الخلاق العليم:
“لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ [البلد : 4]”
فالإنسان خلق في مكابدة وعناء ومشقة, وعليه أن يكابد حتى يسود.
ولو آمن بقوله تعالى:
“يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ [الانشقاق : 6]”
لعلم أنه لا محالة عامل, ولو عمل بجد واجتهاد على مراد الله فسيجد في الدنيا قبل الآخرة جزاء عمله.
فإذا كان الإنسان لا محالة عامل, فليجعل عمله لله, وبذلك ينال راحة البال وهداءة النفس.
والناظر في حال الإنسان يجد أنه لا يتحصل على الراحة بدون تعب وكبد, فلو حُقق للإنسان كل وسائل الراحة والرفاهية, وظل هكذا عاطلا لا يعمل شيئا, ولا يجهد نفسه في شيء, لأصابه الملل والأمراض النفسية من كآبة وما شابها.
ولو كان الإنسان لا يصاب بالأمراض النفسية من الراحة لأصابته الأمراض الجسدية, فلقد جعل الله تعالى صحة جسد الإنسان في حركته واجتهاده, فكلما تحرك أكثر واجتهد أوفر, وكان هذا الجهد أكبر من طاقته أو يستلزمها كلها –بداهة وإلا لما سُمي جهدا-, لتحسنت صحته وزادت قوته وزال الهم والضيق من صدره.
ولأن الإنسان يعرف بفطرته المغروزة فيه أنه مخلوق ليعمر الأرض فإنه يجد السعادة في المجهود البدني الذي يبذله, ومن يمارس تدريبات الأثقال يعرف راحة البال التي يجدها هؤلاء بعد انتهاء تدريبهم, وكذلك الراحة والرضا التي يجدها الإنسان بعد إنهائه أي عمل يحتاج جهدا عضليا, –
إذا كان يقوم به وهو غير ساخط عليه-, فيشعر برضا كبير, ويجيش صدره بمشاعر مختلطه, لأنه يعرف أنه جهده هذا كان في نفع, وليس جهدا افتراضيا مثل الذي يقوم به لاعبو الأثقال. وإنسان هذا العصر يشعر بهذا الشعور أكثر من غيره, وذلك لقلة عمله واشتغاله بيده, واعتماده على فكره.
لذا فراحة الإنسان في جهده, فإذا اجتهد عرف طعم الراحة, أما إذا ارتاح عرف معنى الملل والمرض, ودفعه ذلك للبحث عن التغيير والبحث عن الراحة بشكل آخر, مما يدفعه إلى ارتكاب المعاصي علّه يجد فيها راحة!
فإذا علم الإنسان هذه المعادلة وآمن بها لارتاح وهو يجهد في العمل, لعلمه أن هذا في مصلحته في الدنيا ولعلو منزلته في الآخرة, ولأخذ العمل كتحد شخصي ينجزه, فيحقق الراحة والرضا بالعمل فيحب عمله, فينجز فيه أكثر, فيقتصر الأمر على تعب البدن, ولكن مع الحصول على راحة البال في العمل وبعده.
وقارن بينه وبين من يعمل وهو ساخط, كيف سيخرج نتاجا رديئا, وكيف يصبح العمل مشقة وعذابا بالنسبة له, وكيف لا يستطيع الانتفاع والتلذذ بالراحة بعده!!
فإذا تركنا معادلة جهد الراحة, وجدنا أن سببا رئيسا من أسباب عدم الراحة هو تعليق البشر الراحة على مرحلة قادمة, أو على حصول شيء ما؛
فيظن الصغير أن سيرتاح عندما يكبر, والباحث عن الزواج عندما يتزوج, والنكد مع زوجه بعد الطلاق, والكبير يظن أن مرحلته مرحلة لا راحة فيها, ولو رُد صغيرا ….
وهكذا يعلق الإنسان راحته على أشياء وأوقات, الله أعلم متى وإمكانية وقوعها, وهكذا يظل يترقبها, فإذا لاقاها لم يجد فيها راحته, لأنها لم تكن كما تصور وأراد, فيبحث عن الراحة في غيرها!
وما أصدق الحكمة التي تقول: إذا لم تقدر ما لديك, فلن تحصل على ما تريد (قرأتها بالألمانية, وهناك بالتأكيد بالعربية ما هو قريب منها)
إن حياة الإنسان مجموعة مراحل, وعلى الإنسان أن يقنع نفسه بكل مرحلة فيها, ويعلم أن فيها كلها سعادة وراحة وتعب, فلا يظن بأي حال من الأحوال أنها لا خير فيها ولا راحة, وينتظر ما بعدها حتى يرتاح, فينام هربا, حتى تنقضي هذه المرحلة وتمر, أو يلهي نفسه بأي شيء حتى ينهيها!
وهكذا يكون ممن أصدر حكم الإعدام الجزئي أو الكلي على نفسه! أما إذا آمن أن مراحل الحياة كلها محكومة بمعادلة: جهد الراحة, فسيعيشها كله, ويرتاح فيها ويهنئ!
والسبل المقدمة لراحة الإنسان كثيرة, والسبيل الوحيدة المضمونة هي سبيل خالقه, فهو يعلم من خلق, ويقدم له الخير, كطريق واحد, فيرتاح الإنسان لوضوح هدفه ولوحدة طريقه, فلا يعاني التشتت, الذي يقع فيه متبعي الطرق الأخرى, الذين يسوقونهم في طرق مخالفة للبرنامج المغروز داخل الإنسان!
ولأن الإنسان مخلوق لله, فالله غاية الإنسان في الدنيا والآخرة, فالراحة الحقيقة يجدها عندما يقف بين يدي الله عزوجل ليصلي, بأي شكل كان وبأي دين كان, فعندما يلقي الإنسان الدنيا خلف ظهره, ويقف ليناجي الرب الحبيب, فهذه هي أكبر راحة وهناءة!
وهذه هي الراحة الوحيدة في الدنيا, الصافية من كل تعب, ففي الصلاة راحة بلا تعب, وهذا أكبر دليل على أن الدنيا تعب الإنسان وشقائه, ولكن الإنسان يبحث عن شقائه بيده!
فإذا صححنا منظورنا للدنيا ولدورنا فيها, ارتحنا في تعبنا وبعد تعبنا وفزنا في دنيانا قبل آخرتنا, وعزمنا العزم الشديد على التعب … لنرتاح!
ولله در الإمام أحمد بن حنبل (وقيل الإمام الحسين) والذي سُئل:
متى الراحة يا أبا عبدالله؟
فقال: عند أول قدم نضعها في الجنة.
فما أحكمه وأصحه من جواب!
جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنان بفضل المنان, والسلام عليكم ورحمة الله.
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد