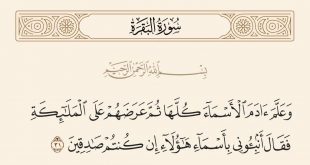نتناول اليوم بإذن الله وعونه سورة جديدة من سور جزء عم, وهي سورة الليل.
وسورة الليل من السور التي لا يوجد بها مفردات قد تغيب عن بعض القراء, فكلها والحمدلله تعالى سهلة ميسرة لكل قارئ. ولكن النقطة الرئيسة في هذه السورة هي مسألة الأقسام المذكورة في أول السورة, وهي قوله تعالى: “َاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى [الليل :1-3],
فما هي العلاقة بين هذه الآيات الثلاثة وبين المقسم عليه وهو قوله تعالى “ِإنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى [الليل : 4]؟ فكما قلنا مسبقا أنه لا بد من وجود علاقة قوية بين المقسم به والمقسم عليه, وكذلك بقية السورة, وإلا يصير الكلام فاقد الترابط.
فما هي العلاقة بين هذه المقسم به وعليه والسورة, نبدأ متوكلين على الله فنقول:
تبدأ السورة بقوله تعالى: “والليل إذا يغشى” والغشيان معروف وهو تغطية شيء بشيء, ومنه اللفظة المشهورة “الغشاء”,
ونلاحظ هنا أن الله تعالى استعمل الفعل المذكور مع الليل في صيغة المضارع وهو “يغشى” وهذا يدل على الاستمرار والمداومة. ولم يذكر الله تعالى هنا أي مفعول لغشيان الليل, فلا نخصص الآية مثل آية الشمس “والليل إذا يغشاها” فنقول المراد الشمس, وإنما نتركها هكذا عامة فيكون المراد من ذلك غشيان الليل لكل ما يغشاه من كائنات وأراض وكواكب…. إلخ.
والملاحظ أن الليل هو الأصل في الكون, فكل الكون غارق في ظلام دامس, ففي الفضاء على الرغم من وجود النجوم والكواكب إلا أنها لا تنير الفضاء, وإنما يراها الإنسان إذا خرج من الغلاف الجوي كمصابيح مضيئة على خلفية سوداء. ثم يقول الله تعالى في الآية التالية “والنهار إذا تجلى”
ونلاحظ أن الفعل المذكور مع النهار مستعمل في صيغة الماضي “تجلى” ولم يستعمل في المضارع, وهكذا استُعمل في سورة الشمس “والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها”, فلماذا استعمل الله مع الليل المضارع ومع النهار الماضي؟
بما أن الله خالف بين الإثنين فلا بد من وجود فارق, فنقول والله أعلم: إن الله تعالى يقسم هنا –وفي سورة الشمس كذلك- بالفعل الظاهر المستمر لليل وهو التغطية المستمرة والستر, -والذي هو الأصل في الكون كما قلنا “الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ [الأنعام : 1]”-
ويقسم كذلك بفعل ماض حدث وهو تجلي النهار, فبعدما خلق الله تعالى الليل (الظلمات) كان كل الكون هكذا مظلما, فجلّى الله تعالى النهار, وحدث هذا مرة واحدة فقط وهي مستمرة لا تجدد فيها, أما الليل فهو دائم الغشيان مستمره!
-أما إذا فهمنا الآيات من باب التفسير الإشاري فيمكننا القول أن المراد من الليل هو ظلمات الكفر والضلال, والنهار هو نور الوحي والهداية.
وكما هو معروف فإن أسباب الضلال كثيرة متعاضدة مستمرة, لذلك استعمل الله تعالى معها صيغة المضارعة, أما الهداية فمصدرها واحد وهو الله تعالى, ولقد أتت هذه الهداية حقا مع الرسول الكريم والقرآن, لذلك استعمل الله تعالى معها صيغة الماضي!-
ثم يأتي القسم الثالث وهو قوله تعالى “وما خلق الذكر والأنثى”, واختلف المفسرون في المراد من هذه الآية فقالوا –كما جاء في تفسير مفاتيح الغيب-:
“المسألة الأولى : في تفسيره وجوه أحدها : أي والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد ، وقيل : هما آدم وحواء وثانيها : أي وخلقه الذكر والأنثى وثالثها : ما بمعنى من أي ومن خلق الذكر والأنثى ، أي والذي خلق الذكر والأنثى.” اهـ
والرأي المشتهر والمتعارف عليه هو أن المراد من “ما” هنا “من” وهي عائدة على الله سبحانه وتعالى, أي أن الله تعالى أقسم بخلقين من مخلوقاته ثم أقسم بعدهما بنفسه بصيغة غير العاقل!
وهذا الفهم مأخوذ من فهمهم لسورة الشمس, عندما فهموا قوله تعالى “ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها”, فقالوا: المراد من “ما سواها” هو حتما الله سبحانه وتعالى!
والعجيب أن “ما” لا تستعمل أساسا في اللغة إلا مع غير العاقل, وهم يقرون بذلك, ويرون أن هذا هو الإساس ولكنهم يستثنون ويقولون بجواز استعمالها مع العاقل! فعلاما استندوا في قولهم هذا؟
العجيب أنهم استندوا إلى الآيات التي نحن بصددها, فهم يستدلون بموطن خلاف ليثبتوا قاعدة استثنائية, أما نحن فنرى أن “ما” لا تستعمل إلا مع غير العاقل
ومن الممكن أن تستعمل مع العاقل إذا كان مبهما أو من باب المشاكلة, وبداهة لا يمكن أن يكون الله عزوجل مبهما فهو أعرف المعارف. أما نحن فنسير تبعا لقواعد اللغة العامة ونقول: المراد من “ما” هنا حتما شيء غير عاقل, فما هو هذا الشيء؟
الإجابة المنطقية على هذا السؤال أن الذي خلق الذكر والأنثى –بأمر الله وتقديره وإرادته- هو النطفة, فالله تعالى يقول في سورة القيامة “أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى [القيامة : 39-37]” ففي سورة القيامة نسب الله تعالى الفعل إلى نفسه, وهنا نسب الفعل إلى النطفة نفسها. ولا حرج في هذا الأمر,
فالله تعالى ينسب الفعل أحيانا إلى نفسه لأنه هو الفاعل الحقيقي المؤثر المقدر, وأحيانا ينسبه إلى المباشر, كما ينسب التوفي إلى نفسه وإلى الملائكة! لذا فإني أرى أنه لا حرج أن يكون المراد من “وما خلق الذكر والأنثى” هو النطفة. وهنا يتجدد السؤال مرة أخرى: إذا قبلنا بهذا الرأي, فما العلاقة بين الليل والنهار والنطفة؟
نقول: أولا : على قولنا هذا فالترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر, فالليل أعم وأشمل من النهار والنهار أكبر بكثير من النطفة.
ثانيا: الله عزوجل يقدم بهذه الآيات تشبيها عجيبا لاختلاف أفعال الناس, فهناك الليل المظلم وهو إشارة إلى أفعال الشر والضلال, وعلى العكس من الليل فهناك النهار المضيء, والنهاروالليل والنهار كلاهما يشكلان وحدة واحدة في منظومة بناء الكون يتعاقبان فيعم هذا ثم ينسحب ويأتي ذاك,
فهما في تسابق وتداخل إلى يوم القيامة. وعلى الرغم من اختلاف الليل والنهار في الطبيعة والحجم فإنهما مكملان لبعضهما منشئان شيئا واحدا وهو اليوم. ثم ينتقل الله تعالى نقلة نوعية كبيرة إلى النطفة الصغيرة الحقيرة والتي منها ينشأ الإنسان, فيقول للإنسان أنه قد يأتي من هذا الواحد الصغير تنوع واختلاف, على العكس من الإثنين الكبيرين, الذين منهما نشأ شيء واحد!
إذا فالعلاقة بين هذه المقسمات بها هو الاختلاف في الطبيعة, فهناك النقيض الذي يكون مع نقيضه واحدا, وهناك الصغير الذي يتكون منه النقيضان.
وفي هذه الآيات إشارة عظيمة في الليل وما خلق الذكر والأنثى, فالليل إشارة إلى عظم وكبر الضلال وخسرانه, فقد يقدم بعض الناس من الأفعال الكثير والعظيم والهائل ولكنها لغير الله عزوجل فهي سوداء مظلمة لا نفع فيها “قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [الكهف : 104-103]“
فانظر إلى حجم الليل وعلى الرغم من ذلك لأنه ظلام فهو لم ينفع صاحبه, وانظر إلى صغر النطفة وعلى الرغم من ذلك فلقد نشأ منها ما لا يقارن بها, فلا وجه للمقارنة بين حجم النطفة التي لا ترى وبين حجم الإنسان البالغ, وفي هذا إشارة إلى مضاعفة ثواب وحجم الأجر على العمل الصالح الذي يعطيه الله عزوجل للمتقي المنفق,
وهذا مشابه لقوله تعالى “مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة : 261]”.
إذا فالله تعالى يبرز في هذه الآيات الثلاثة ثلاثة أنواع اختلاف, فهناك اختلاف الهيئة والظهور كما بين الليل والنهار, فالليل وإن كان الأكبر فإن النهار هو الأنفع والأظهر! وهناك اختلاف حجم كما بين الليل والنطفة, فالليل على كبره لا خير فيه وهو ممحوق,
أما النطفة فهي إلى نماء وتكاثر وتضاعف, وهناك اختلاف طبيعة فالليل والنهار يتكاملان ليشكلا واحدا, والنطفة تنقسم ليخرج منها إثنان. وبهذا كله يقسم الله على ” إن سعيكم لشتى” أي أن سعي الناس في الحياة مختلف متنوع متفرق, كما اختلفت وتنوعت هذه المقسمات بها. ونجد أن الحديث في هذه السورة يركز كل التركيز على التقوى الحقيقية من إخلاص العمل لله عزوجل وما يتبعه من تصديق له وهو الإنفاق,
لذلك يقول الله تعالى بعد ذلك “فأما من أعطى واتقى …. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى”
وعلى النقيض من ذلك يأتي قوله تعالى “وأما من بخل واستغنى …..فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى”.
فانظر أخي في الله إلى هذا التنوع البديع العجيب والفارق الرهيب بين المقسمات بها والذي قدمه الله عزوجل ليدلل به على اختلاف سعي الناس, فهي صورة طبيعية عرضت طرفي النقيض في الصغر والكبر, ولا أعتقد أنها تخطر ببال بشر.
قد يقول قائل: قد يكون الرأي مقبولا هنا, ولكن ماذا تقول في آية الشمس “ونفس وما سواها”؟
نقول: الناظر في السورة من أولها إلى الآية السابقة لهذه يجد أن الله تعالى يقسم بالمخلوق وبفعل له, فيقول: “والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها” ثم بعد ذلك يغير شكل الآيات فيقول: “والسماء وما بناها ونفس وما سواها”
فإذا كان بعض المفسرين قد رأى أن المراد من “ما” هنا المصدرية, أي: والسماء وبناءها والنفس وتسويتها”,
-فليس الأمر اتفاقا أن المراد ب “ما” الله تعالى- فلنا أن نرى أن المراد من ذلك هو المادة التي بنى الله عزوجل بها السماء, وكذلك البنية التي أنشأ الله تعالى النفس فيها.
وكما قلنا في سورة الليل نقول هنا, الله تعالى نسب فعل إلهام الفجور والتقوى إلى مادة الإنسان نفسه, أي أن الله تعالى خلق الإنسان وسواه على هيئة وفي طبيعة تجعله يفعل الفجور والتقوى, وهذا شيء في طبيعة الإنسان نفسه, لا أنه يكتسب الفجور من المجتمع, وإنما الإنسان بطبعه يحمل صفات الانحراف, كما يحمل صفات التقوى.
وأعتقد أن هذا الفهم لا حرج فيه, فهو لا يخالف اللغة المشتهرة, كما أنه لا يخالف العقيدة, فهو ينسب الفعل ظاهرا إلى السبب الأرضي, ولكنه يقر أنه في نهاية المطاف هو بتقدير الله عزوجل وتسويته, فليس بناء النفس هو الفاعل وإنما هو مفعول لأمر الله وتقديره.
وبهذا نكون قد أظهرنا العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه في سورة الليل , فهناك مقابلة بين الآية الأولى والثانية,(الليل والنهار) وبين الأولى والثالثة (الليل والنطفة) وبين الآية الأولى والثانية في مقابل الثالثة(الليل والنهار في مقابل النطفة), ووضحنا الصورة البديعة في الآيات, وعلى القارئ أن يقوم بربط باقي آيات السورة ببعضها وسيرى كما هي بناء متناسق بديع لا مثيل له.
غفر الله لنا ولكم الزلل والسلام عليكم ورحمة الله.
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد