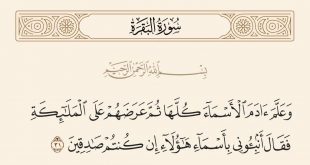إن الإدعاء أن محمدا هو من كتب القرآن وألفه من عند نفسه! دعوى ظهرت وانتشرت لفترات طويلة ولا تزال تجد لها من يدافع عنها حتى الآن, وذلك لأن ذلك المتبجح الذي يدعي هذه الدعوى ما قرأ القرآن ولا فهمه, واستند إلى بعض الأفهام البالية الواردة في “تفسير” آي القرآن
ونسى ذلك المتهوك أن العرب في عهد الرسول الكريم عندما سمعوا القرآن الكريم أقروا وجزموا أن هذا القرآن لا يمكن بحال أن يكون من عند محمد وقالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق …. إلخ ما وصفوا به القرآن, ولكن على الرغم من ذلك لم يدخلوا في الإسلام!
لذا استحقوا ذلك الوصف المهين “الكفار” لأنهم عرفوا الحق وأنكروه, فالعربي بسليقته كان يعلم أن الكلام الذي جاء به محمد لا يمكن أن يكون من عنده أو من عند إنسان عربي بأي حال, لم؟
لأنه ما رأى أو سمع نصوصا مشابهة –ولا نقول مماثلة- لهذا النص الذي أتى به محمد, ومن المعلوم بداهة أن أي إنسان كاتب فإن كتابته تتأثر لا محالة ببيئته وبعصره ولكن ما أتى به محمد مخالف تماما لما اعتاده العرب في كتابتهم وألفوه بشكل جذري,
ونطلب إلى القارئ أن يرجع إلى الشعر العربي القديم فيقرأ منه ما يشاء وكذلك إلى ما ورد من النثر ويقارنه بما جاء في سورة العاديات أو النازعات أو المرسلات أو الذاريات, ولن يرى أي وجه تشابه, وإنما سيرى بونا شاسعا في المعاني والألفاظ والأهداف! راجع هذه السور على موقعنا وسترى فيها عجبا- وليس لهذا أي تبرير سوى القول أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند محمد, فلما عاندوا واستمروا على كفرهم استحقوا أن يكون مرجعهم إلى النار!
ومرت الأيام والسنون ومات العرب الخلص من الصحابة ومن عايشهم ودخل الناس في دين الله أفواجا من كل صوب وحدب وقدم لهم المسلمون كتاب الله ولكن لم يجد المسلمون الجدد في الكتاب ما وجده الأوائل وإنما وجدوا فيه بعض المصاعب وبعض المواطن الغير مفهومة, فجد بعض العلماء ليقدموا تفسيرا !
للكتاب فتناولوه تناولا عجيبا, -ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى كتابنا : لماذا فسروا القرآن- طمس الكثير من آيات القرآن البينات, ونقدم لك عزيزي القارئ نموذجا آخر يبرهن بأن القرآن لا محالة هو من عند الله عزوجل وليس من عند محمد وهو سورة الفجر!
وقد تكون سورة الفجر من السور التي لا يغمض شيء من معانيها على القارئ ولكن الإبهار في هذه السورة يكمن في بنائها, ففي هذه السورة سيقابل القارئ بناءا عجيبا سنقدمه له بإذن الله وعونه هنيئا مريئا, ونبدأ متوكلين على الله العليم:
سورة الفجر هي من السور المكية وهي من أوائل ما نزل من القرآن حتى أنه قيل أنها السورة العاشرة في ترتيب النزول, وهي سورة تعالج قضية رئيسة من قضايا العقيدة وهي مسألة أن الله مطلع على عباده ويجازيهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة, وجاء هذا المعنى في قوله تعالى “ إن ربك لبالمرصاد“.
فإذا نحن نظرنا في أقوال السادة المفسرين ما وجدنا هناك أي معنى جامع لهذه السورة ولا حتى بعض المواضيع المتصلة بل قدموا السورة بعض الآيات المنفصلات التي لا يربطها رابط ولا يضمها موضوع, ولأنهم يقبلون أن تكون سور القرآن بعض الآيات المنفصلات احتاروا أيما حيرة في معاني الآيات الواردة في أول السورة, أما نحن فلأننا نؤمن أن آي القرآن هي كلام أحكم الحاكمين علمنا أنه حتما ثمة علاقة بين المقسم به والمقسم عليه, والذي قال أكثر المفسرين أنه محذوف!
وكذلك هناك علاقة بين الآيات في السورة كلها فلما نظرنا في السورة على هذا الأساس فتح الله عزوجل لنا فيها فتوحا من عنده, ولكن قبل أن نبدأ في تناول السورة نقدم لك عزيزي القارئ أقوال المفسرين فيها:
اختلف المفسرون في مداليل المفردات المذكورات في أول السورة, فقالوا أن الفجر هو الفجر –أو صلاة الفجر!- ولكن اختلفوا هل هو فجر عام أم هو فجر يوم معين كيوم النحر أو يوم المحرم, ثم اختلفوا كذلك في المراد من الليال العشر, فقالوا أنها عشر ذي الحجة أو عشر المحرم أو أنها العشر الأواخر من رمضان!
واختلفوا في المراد من الشفع والوتر اختلافا شنيعا حتى أنا وجدنا الإمام الفخر الرازي يقول: “اضطرب المفسرون في تفسير الشفع والوتر وأكثروا فيه ……” وذكروا في تفسيرهم! للشفع والوتر تفسيرات عديدة, منها كما جاء في تفسير الفخر الرازي:
” أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ، ………, والشفع هو يومان بعد يوم النحر ، الوتر هو اليوم الثالث ، ……., وثالثها : الوتر آدم شفع بزوجته ، وفي رواية أخرى الشفع آدم وحواء والوتر هو الله تعالى ورابعها : الوتر ما كان وتراً من الصلوات كالمغرب والشفع ما كان شفعاً منها, …………, وخامسها : الشفع هو الخلق كله لقوله تعالى : { وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } [ الذاريات : 49 ] وقوله : { وخلقناكم أزواجا } [ النبأ : 8 ] والوتر هو الله تعالى, …….., وسابعها : الشفع درجات الجنة وهي ثمانية ، والوتر دركات النار وهي سبعة وثامنها : الشفع صفات الخلق كالعلم والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموت ، أما الوتر فهو صفة الحق وجود بلا عدم ، حياة بلا موت ، علم بلا جهل ، قدرة بلا عجز ، عز بلا ذل وتاسعها : المراد بالشفع والوتر ، نفس العدد فكأنه أقسم بالحساب الذي لا بد للخلق منه وهو بمنزلة الكتاب والبيان الذي من الله به على العباد, …………, وعاشرها : قال مقاتل الشفع هو الأيام والليالي والوتر هو اليوم الذي لا ليل بعده وهو يوم القيامة الحادي عشر : الشفع كل نبي له اسمان مثل محمد وأحمد والمسيح وعيسى ويونس وذي النون والوتر كل نبي له اسم واحد مثل آدم ونوح وإبراهيم الثاني عشر : الشفع آدم وحواء والوتر مريم الثالث عشر : الشفع العيون الإثنتا عشرة ، التي فجرها الله تعالى لموسى عليه السلام والوتر الآيات التسع التي أوتى موسى في قوله : { وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا موسى تِسْعَ ءايات بَيّنَاتٍ } [ الإسراء : 101 ] ، الرابع عشر : الشفع أيام عاد والوتر لياليهم لقوله تعالى : { سَبْعَ لَيَالٍ وثمانية أَيَّامٍ حُسُوماً } [ الحاقة : 7 ] الخامس عشر : الشفع البروج الإثنا عشر لقوله تعالى : { جَعَلَ فِي السماء بُرُوجاً } [ الفرقان : 61 ] والوتر الكواكب السبعة السادس عشر : الشفع الشهر الذي يتم ثلاثين يوماً ، والوتر الشهر الذي يتم تسعة وعشرين يوماً السابع عشر : الشفع الأعضاء والوتر القلب ، قال تعالى : { مَّا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } [ الأحزاب : 4 ] ، الثامن عشر : الشفع الشفتان والوتر اللسان قال تعالى : { وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ } [ البلد : 9 ] التاسع عشر : الشفع السجدتان والوتر الركوع العشرون : الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة ، واعلم أن الذي يدل عليه الظاهر ، أن الشفع والوتر أمران شريفان ، أقسم الله تعالى بهما ، وكل هذه الوجوه التي ذكرناها محتمل ، والظاهر لا إشعار له بشيء من هذه الأشياء على التعيين ، فإن ثبت في شيء منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أهل التأويل حكم بأنه هو المراد ، وإن لم يثبت ، فيجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز لا على وجه القطع ، ولقائل أن يقول أيضاً : إني أحمل الكلام على الكل لأن الألف واللام في الشفع والوتر تفيد العموم ” اهـ
فانظر أخي في الله إلى مقدار حيرة المفسرين في تحديد مدلول الشفع والوتر حتى أن الإمام الفخر الرازي في نهاية المطاف لا يستطيع أن يحدد فيها معنى ويقبل قول من يحملها على الكل! وكل هذا راجع إلى النظرة الاجتزائية للسورة ولو قرأوها كلها وحدة واحدة لما احتاروا هذه الحيرة.
ولما تناولوا الآية التالية “والليل إذا يسر” ترك عامتهم قول الرب العليم وأخذوا بأقوال فلان وعلان من الناس! ومضوا على هذا النهج إلى آخر السورة فقطوعها آيات منفصلات وتناولوها كما هي.
ونبدأ بإذن الله في تقديم تصورنا نحن لهذه السورة الذي يربطها كلها من أولها إلى آخرها بإذن الله تعالى, ولكن قبل أن نقدم تصورنا لها نوضح أن النظرة المنقوصة للسورة ليست فعلا خاصا بالأقدمين فقط, فلقد رأينا في المعاصرين من وقع في نفس المأزق وهو الدكتور محمد شحرور, فلقد حاول أن يقدم تأويلا عصريا للآيات الواردة في أول سورة الفجر فقال:
“(( فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال : “والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر” حيث إنّ الفجر هو الانفجار الكوني الأول “وليال عشر” معناه أنّ المادة مرّت بعشر مراحل للتطوّر حتى أصبحت شفّافة للضوء ، لذا أتبعها بقوله “والشفع والوتر” حيث أنّ أول عنصر تكوّن في هذا الوجود وهو الهيدروجين وفيه الشفع في النواة والوتر في المدار ،
وقد أكّد هذا في قوله : “وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستّة أيام وكان عرشه على الماء ” (هود،7) والهيدروجين هو مولّد الماء ، أي بعد هذه المراحل العشر أصبح الوجود قابلاً للإبصار لذا قال : “الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون” (الأنعام،1) )) -الكتاب والقرآن : قراءة معاصرة. ص235- . ” اهـ
ولقد انبرى بعض الأخوة للرد على ما قاله فحاولوا أن يفندوا ما قاله, ولكن فعله هو نفس فعلهم تجزأة للسورة وخروج بمضمون لا علاقة له بها, أما نحن فنجزم بخطأ الدكتور شحرور من خلال البناء العام للسورة, ونبدأ بإذن الله تعالى في عرض البناء العام لهذه السورة الجليلة:
الناظر في هذه السورة يجد أنها بدأت بأربعة أقسام وهي قوله تعالى “وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4)” ثم ثنى الله عزوجل بعد ذلك بالسؤال: ” هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) “
فإذا نظرنا في الآيات التاليات لهذه الخمسة لا نجد جواب القسم , وإنما نجد آيات تدعو النبي الكريم إلى تذكر فعل الله عزوجل بعاد وثمود وفرعون وكيف أنزل الله بهم العذاب, وبعد ذلك تخبرنا السورة “إن ربك لبالمرصاد” ثم تتحدث عن حال الإنسان عند ابتلاء الله عزوجل له بالنعيم وبالتقدير ثم تذكر موقف مجيئ الله عزوجل في اليوم الآخر للحساب وعن المجيء بجهنم وعن تذكر الإنسان وعن رجوع النفس إلى ربها ودخولها الجنة.
فما هو الرابط الذي يربط هذه المعاني؟ إن اكتشاف الرابط يؤدي لا محالة إلى تحديد معان الآيات الكريمات الواردة في أول السورة, لذا نقدم لك عزيزي القارئ ذلك الرابط أو المنظور العام للسورة ثم نبدأ في تناول السورة:
المنظور العام للسورة:
تدور السورة في فلك إثبات أن الله عزوجل مطلع على العباد وعلى أعمالهم في الدنيا والآخرة وليس غافلا عنهم وأنه يعاقبهم في الدنيا على ذلك وهذا الحساب والعذاب يخضع لقوانين معينة فإذا حدث شروطه نزل العذاب وأن الإنسان هو الذي يتسبب في إنزال هذا العذاب, وتوضح السورة أن العذاب في الدنيا هو مهما كان عذاب صغير لا يقارن بالعذاب الوارد في الآخرة فهناك سيكون مرجعين إثنين إما إلى النار والعذاب الشديد أو إلى الله عزوجل وإلى جنة النعيم. ونبدأ بعون الله في تناول السورة الكريمة:
تبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى “والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر” فما هو المراد هذه المقسمات والتي يقول الله عزوجل بعدها ” هل في ذلك قسم لذي حجر”؟
إن أفضل تحديد للمراد من هذه الأقسام هو النظر في المقسم عليه أو جواب القسم, فما هو جواب القسم لهذه الآيات؟
يأتي جواب القسم في السورة واضحا وضوحا جليا وعلى الرغم من ذلك وجدنا فيه اختلافا, فيقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره:
“واعلم أن في جواب القسم وجهين الأول : أن جواب القسم هو قوله : { إِنَّ رَبَّكَ لبالمرصاد } وما بين الموضعين معترض بينهما, الثاني : قال صاحب «الكشاف» : المقسم عليه محذوف وهو لنعذبن الكافرين ، يدل عليه قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ } إلى قوله { فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ } وهذا أولى من الوجه الأول لأنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل مذهب ، فكان أدخل في التخويف ، فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولاً هو ذلك .” اهـ
فكما نرى فإن الإمام الفخر يرجح أن يكون المقسم عليه محذوفا ويقدره كما قدره الإمام الزمخشري, وكما قلنا سابقا ووضحنا أن القول بمحذوف في كتاب الله عزوجل قول لا دليل عليه ولا برهان وهو تخرص في إضافة كلمات ومعان إلى كتاب الله العزيز. إذا فجواب القسم هو قوله تعالى ” إن ربك لبالمرصاد”.
إذا فالله تعالى يقسم بأشياء على أنه لبالمرصاد ويأتي بين القسم والجواب بعدة آيات تتحدث عن الإهلاك وصب العذاب فيفهم بداهة أن هذه الآيات هي تصديق للمقسم عليه, وهذا هو العجيب في هذه السورة
فمن المألوف والمعروف أن الإنسان عندما يقسم على شيء فإنه يقسم بكذا على كذا ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم الأدلة على ما يقول حتى يزيل الشك الذي يراود الإنسان بشأن المقسم عليه
أما هنا فنجد أن الله تعالى أقسم بمقسمات عدة ثم يقول بعد ذلك للإنسان دافعا إياه للتفكر فيها “هل في ذلك قسم لذي حجر” وقبل أن يأتي بجواب القسم يذكره بفعل الله عزوجل مع قوم كذا وكذا, فإذا أتى الإنسان إلى جواب القسم سلم حتما به وهو أن الله تعالى لبالمرصاد, فلقد قدم له مقدما الأدلة على الدعوى فيُرفع الاعتراض أو الشك قبل وقوعه!
وبما أن الله تعالى يقسم أنه لبالمرصاد ويقدم الأدلة التاريخية الهائلة على ذلك, فهناك حتما علاقة بين هذه المقسمات وبين المقسم عليه, فما هي هذه العلاقة في هذه المقسمات التي تحتاج إلى إعمال ذهن في استخراج العلاقة والصورة البديعة الموجودة فيها؟
في هذه المقسمات ثمة فجر وليال عشر وشفع ووتر وليل يسر , ويفترض أن تكون هذه الأشياء دليل على أن الله لبالمرصاد وأنه غير غافل عن العباد, فكيف هذا؟ وما هو هذا العامل المشترك وما هي هذه الصورة الموجودة في الآيات؟ نبدأ أولا بتحديد مدلول كل كلمة ثم نقدم بعد ذلك هذه الصورة:
الفجر معروف وهو الفجر! أي وقت ذهاب الليل والظلام ودخول الضوء والنهار, والفجر كما يبدو من بنائه يدل على الانفجار! وهو كما جاء في المقاييس:
“الفاء والجيم والراء أصلٌ واحدٌ، وهو التفتح في الشَّيء. من ذلك الفَجْر: انفِجار الظُّلمة عن الصُّبح. ومنه: انفجَرَ الماء انفجاراً: تفتَّحَ. والفُجْرَة موضع تفتُّح الماء. ثمَّ كثُر هذا حتَّى صار الانبعاثُ والتفتُّح في المعاصي فُجوراً. ………” اهـ
فإذا نحن نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أنه يأتي بهذا المعنى فهو إما انفجار ماء “ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة : 74]” (ونطلب إلى القارئ أن ينتبه إلى كلمة الحجارة الواردة في هذه الآية!) أو الفجر المعروف.
واستعملت العربية الفجر مع هذا المدلول لأن في هذا الوقت تنفجر الظلمة عن الصبح كما قال ابن فارس.
إذا فالفجر هو الفجر وهو معروف, ولا دليل في الآية على أنه فجر مخصوص أو صلاة الفجر فيحمل على الفجر, فما هي الليال العشر؟
الناظر في أقوال السادة المفسرين في هذا الشأن يجد عجبا, فما علاقة ليالي رمضان الأخيرة الذي لم يكن قد فرض صيامه بعد –تذكر أن هذه السورة هي العاشرة في النزول كما يروى- أو بعشر ذي الحجة, فهل كان الرسول أو المسلمون قد عرفوا أن الله سيبقى نظام الحج كما هو ولن يغيره؟ وكذلك نفس الوضع مع ليالي المحرم أو أي ليال ذكروها؟!
وبغض النظر عن مكية السورة ومدنيتها وترتيب نزولها, ما علاقة هذه الآيات بالمقسم عليه وهو “إن ربك لبالمرصاد” وما علاقتها بهلاك عاد وثمود وفرعون؟! بداهة ليس هناك أي علاقة,
إذا فيجب علينا أن نبحث عن ليال لها تعلق بهؤلاء الأقوام أو ببعضهم, والحق يقال أنه قد جال في خاطري أن تكون هذه الليال هي ليال موسى العشر ” وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ [الأعراف : 142]”
وقلت أن موسى له ذكر ضمني في السورة من خلال ذكر فرعون, ولكن ظهر بعد ذلك أن الآيات تتحدث عن فرعون وآله وجيشه ولم تذكر موسى فلا ندخله نحن, كما أنه لا علاقة لها أيضا بالمقسم عليه. إذا فما هذه الليال العشر المرتبطات بالآيات التاليات؟
إذا نحن نظرنا في نزول العذاب بعاد وجدنا أن الله تعالى يقول:
” وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ [الحاقة : 6,7]
إذا فالعذاب نزل بعاد في سبع ليال, فإذا نظرنا في حال ثمود وجدنا أن الله تعالى يقول: ” فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ [هود :65, 66]
فإذا نحن جمعنا ليال هذه الأيام الثلاثة الذي انتظروا فيها العذاب, وكانت هذه ليال عذاب معنوي وكما يقال في المثل “وقوع البلاء ولا انتظاره” فهم ظلوا في ترقب ثلاثة أيام وثلاثة ليال ثم نزل بهم العذاب فأهلكوا بالصيحة الطاغية مباشرة!
وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
“قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة فقد رغبهم في الإيمان ، وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول العذاب ، فقالوا وما علامة ذلك؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة ، وفي الثاني محمرة ، وفي الثالث مسودة ، ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع ، فلما رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة والصاعقة والعذاب” اهـ
فإذا نحن قلنا أن الليال العشر هي ليال العذاب عند عاد وليال انتظار العذاب وترقبه عند ثمود –والتي هي عذاب أيضا- فنكون قد أتينا بليال لها علاقة بالمقسم عليه, وكما قلنا فإن هذه الآيات تحتاج إلى إعمال فكر كما قال الله “هل في ذلك قسم لذي حجر” .
وبعدما حددنا مدلول القجر ورجحنا مدلول الليال العشر ننتقل إلى الشفع والوتر, وكما رأينا فقد اختلف المفسرون فيها اختلافا شنيعا وأتوا فيها بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها أي علاقة بالسورة, فإذا نحن نظرنا في السورة وفي اللغة استطعنا أن نرجح المدلول المراد من الشفع والوتر في الآية, ونبدأ أولا بالبحث في معنى الشفع في المعاجم, فنجد أن ابن منظور يقول في اللسان:
“الشفع: خلاف الوَتْر، وهو الزوج. تقول: كانَ وَتْراً فَشَفَعْتُه شَفْعاً.
وشَفَعَ الوَتْرَ من العَدَدِ شَفْعاً: صيَّره زَوْجاً؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي لسويد بن كراع وإِنما هو لجرير: وما باتَ قَوْمٌ ضامِنينَ لَنا دَماً فَيَشْفِينَا، إِلاَّ دِماءٌ شَوافِعُ أَي لم نَكُ نُطالِبُ بِدَمِ قتيل منّا قوماً فَنَشْتَفيَ إِلا بقتل جماعة، وذلك لعزتنا وقوتنا على إِدراك الثَّأْر.
والشَّفِيعُ من الأَعْداد: ما كان زوجاً، تقول: كان وَتْراً فشَفَعْتُه بآخر ………. وناقة شافِعٌ: في بطنها ولد يَتْبَعُها أو يَتْبَعُها ولد بَشْفَعَها، وقيل: في بطنها ولو يَسْبعُها آخَرُ ونحو ذلك تقول منه: شَفَعَتِ الناقةُ شَفْعاً” اهـ
فإذا نحن نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:
“الشين والفاء والعين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على مقارنة الشيئين. من ذلك الشَّفْع خلاف الوَتْر. تقول: كان فرداَ فشفَعْتُه. ” اهـ
إذا فكما رأينا من خلال اللسان والمقاييس فإن الشفع هو خلاف الوتر! والوتر كما سنرى فهو النقص, وهو خلاف الشفع! إذا فالشفع كما ذكر ابن فارس مقارنة الشيئين, وهو لا يقصد المقارنة بمفهومها المعاصر وإنما يقصد ضم الشيء إلى الشيء وبهذا أكون قد قرنته به!
فالإنسان يكون فردا بنفسه فإذا ضم إليه غيره فقد شفع به! (وهناك فرق بين الشفع والزوج, فالزوج هو واحد الإثنين من الأجناس المختلفة! فالرجل زوج عندما يكون هناك امرأة!)
فإذا نحن نظرنا في اللسان في معنى الوتر
وجدنا أن ابن منظور يقول:
“الوِتْرُ والوَتْرُ: الفَرْدُ أَو ما لم يَتَشَفَّعْ من العَدَدِ. ……………… ووَتَرْتُ الرجلَ: أَفزعتُه؛ عن الفراء. ووَترَهُ حَقَّه وماله: نَقَصَه إِياه. وفي التنزيل العزيز: ولن يَتِرَكُمْ أَعمالكم. وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأَنما وتر أَهله وماله؛ أَي نقص أَهله وماله وبقي فرداً؛ يقال: وتَرْتُه إِذا نَقَصْتَه فكأَنك جعلته وتراً بعد أَن كان كثيراً، وقيل: هو من الوَتْرِ الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أَو نهب أَو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتِلَ حَمِيمُهُ أَو سُلِبَ أَهله وماله؛ ……….. ولن يَتِرَكُمْ أَعمالَكم، يقول: لن يَنْقُصَكُمْ من ثوابكم شيئاً. وقال الجوهري: أَي لن يَنْتَقِصَكم في أَعمالكم، كما تقول: دخلت البيت، وأَنت تريد في البيت، وتقول: قد وَتَرْتُه حَقَّه إِذا نَقَصْتَه، وأَحد القولين قريب من الآخر. وفي الحديث: اعمل من وراء البحر فإِن الله لن يَتِرَكَ من عملك شيئاً أَي لن يَنْقُصَك. والتَّواتُرُ: التتابُعُ، وقيل: هو تتابع الأَشياء وبينها فَجَواتٌ وفَتَراتٌ. وقال اللحياني: تواتَرَت الإِبل والقَطا وكلُّ شيء إِذا جاء بعضه في إِثر بعض ولم تجئ مُصْطَفَّةً؛ وقال حميد بن ثور: قَرِينَةُ سَبْعٍ، وإِن تواتَرْنَ مَرَّةً، ضُرِبْنَ وصَفَّتْ أَرْؤُسٌ وجُنُوبُ وليست المُتَواتِرَةُ كالمُتَدارِكَةِ والمُتَتابِعة. ……. وجاءت الخيل تَتْرى إِذا جاءت متقطعة؛ وكذلك الأَنبياء: بين كل نبيين دهر طويل. الجوهري: تَتْرى فيها لغتن: تنوّن ولا تنوّن مثل عَلْقى، فمن ترك صرفها في المعرفة جعل أَلفها أَلف تأْنيث، وهو أَجود، وأَصلها وَتْرى من الوِتْرِ وهو الفرد، وتَتْرى أَي واحداً بعد واحد، ومن نونها جعلها ملحقة. وقال أَبو هريرة: لا بأْس بقضاء رمضان تَتْرى أَي متقطعاً. ” اهـ
إذا فكما رأينا فإن الوتر هو عملية الإفراد أو الإنقاص, وهناك فارق بين الوتر والفرد, فإذا كان الإنسان سليما غانما معافا لا يقال له وتر, أما إذا كان معه أقارب أو أصحاب فخلوه فيصير وترا لأنه كان مشفوعا ومحميا فوُتر.
إذا فكما رأينا فإن المراد من الشفع هو الضم والإلحاق والوتر هو الإفراد والإنقاص, فما المراد منهما في هذا السياق؟
لقد ذكر السادة المفسرون معان عدة للشفع والوتر ولكنهم عقدوا المسألة وصعبوها على أنفسهم وعلينا, فالمراد من الشفع والوتر هو مسألة أو عملية الشفع والوتر, فالنص لم يخصص أي مدلول من المداليل التي ذكرها المفسرون احتمالا, أما نحن فنأخذ مدلول الكلمة نفسها وهو الإلحاق والضم والإفراد والنقص!
فإذا نحن أخذنا بمعنى الكلمتين! وجدنا أن السياق قد انتظم, فالله عزوجل يقسم بعملية العطاء والمنع الذي يبتلي بها كل الناس وكل الأقوام في كل الأزمنة وغالبا ما يرسب الإنسان في الامتحان –وتذكر السورة نموذجا مباشرا لذلك في سياقها ونماذج غير مباشرة-
فعندما يعطي الله عزوجل الإنسان يأمره بالحمد, ولكن غالبا ما ينسى الإنسان ويطغى – ونطلب إلى القارئ الانتباه إلى النسيان هذا فسنعود إليه لاحقا!- وعندما يمنع الله عزوجل فيمنع لكي يتضرع الإنسان إليه ويسأله, فكله ابتلاء بالنقص أو الزيادة, فالله يعطي من يشاء كما يشاء بحكمة وقدر” لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الشورى : 12]”
وقد تبتلى الأمم بالشفع أو الوتر فينسون وعندما ينسون يفتح عليهم حتى يهلكوا أنفسهم بأنفسهم : “فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ [الأنعام : 44]
إذا فالله تعالى يقسم بالشفع الذي أعطاه لعاد وثمود وآل فرعون فطغوا وتجبروا واعتدوا بأنفسهم وبه وظنوا أنه حام لهم ومانع فلم يمنعهم ذلك من أمر الله, فإنه إذا جاء لا راد له. ويذكر القرآن أن هذا الابتلاء حدث مع فرعون وآله صراحة فيقول: “وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ [الأعراف : 131,130]
فحدث معهم عملية الإيتار فلم يتذكروا, -ونركز على التذكر- وعندما كانوا يشفعون “جاءتهم الحسنة- كانوا يردونها إلى أنفسهم وينسبونها لهم.
إذا فالمراد من الشفع والوتر هو عملية الشفع والوتر, ولا يبقى أمامنا من المقسمات بها إلا “والليل إذا يسر” وهي آية واضحة المعنى والمبنى, ولكنا للأسف وجدنا أن بعض المفسرين طمس هذا المعنى فقال أن المراد ليس يسر ولكنى يُسرى فيه!!! فإذا نحن نظرنا في تفسير مفاتيح الغيب وجدنا أن الإمام الفخر الرازي ذكر هذا القول احتمالا, فقال:
“المسألة الأولى : { إِذَا يَسْرِ } إذا يمضي كما قال : { واليل إِذَا أَدْبَرَ } [ المدثر : 33 ] وقوله : { واليل إِذَا عَسْعَسَ } [ التكوير : 17 ] وسراها ومضيها وانقضاؤها أو يقال : سراها هو السير فيها ، وقال قتادة : { إِذَا يَسْرِ } أي إذا جاء وأقبل .
المسألة الثانية : أكثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة بل العموم بدليل قوله : { واليل إِذَا أَدْبَرَ } { واليل إِذَا عَسْعَسَ }
ولأن نعمة الله بتعاقب الليل والنهار واختلاف مقاديرهما على الخلق عظيمة ، فصح أن يقسم به لأن فيه تنبيهاً على أن تعاقبهما بتدبيره مدبر حكيم عالم بجميع المعلومات ، وقال مقاتل : هي ليلة المزدلفة فقوله : { إِذَا يَسْرِ } أي إذا يسار فيه كما يقال : ليل نائم لوقوع النوم فيه ، وليل ساهر لوقوع السهر فيه ، وهي ليلة يقع السري في أولها عند الدفع من عرفات إلى المزدلفة ، وفي آخرها كما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله في هذه الليل ، وإنما يجوز ذلك عند الشافعي رحمه الله بعد نصف الليل .” اهـ
ولست أدري لم يذكر هذا الاحتمال البعيد وكثير من أمثاله في كتب التفسير فتمتلأ بأقوال لا علاقة لها باللفظ ويتوه القارئ في تحديد المعنى المراد ثم نجد بعد ذلك من يتعصب لقول لا علاقة له باللفظة, وإذا كان الإمام قد ذكر القول احتمالا فهناك غيره من يذكرون هذه الأقوال ويتعصبون لها لأنها صادرة عن فلان, على الرغم من كونها مخالفة لمعنى اللفظة!
فإذا نحن نظرنا على سبيل المثال في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:
“….. والسُّرَى سير اللَّيل، يقال سَرَيْت وأسريت. قال:والسَّراء: شجرٌ.
وسَرَاة الشيء: ظَهْره. وَسَراة النَّهار: ارتفاعُهُ.” اهـ
وسبب هذه الإشكالية عندهم أن السرى هو السير بالليل, ولست أدري ما الذي يمنع أن ينسب نفس الفعل إلى الليل؟ أما هم فقالوا: الليل يسرى فيه ولا يسر! ولست أدري كيف يقول الله شيئا فيعدلونه! إن هذه الآية آية جلية في وصف فعل طبيعي, فالآية تتحدث عن مسير الليل وذهابه.
إذا بعد هذه الرحلة الطويلة إلى حد ما في تحديد مداليل هذه الآيات نسأل:
ما هو الرابط الذي يربط هذه الآيات بالمقسم عليه “إن ربك لبالمرصاد”؟
نقول: الرابط هو أن الله تعالى يقدم صورة بديعة على رصده لخلقه وتنظيمه لهم وحسابهم وعقابهم فيقسم بالفجر الذي يأتي فيزيح الليل, فكما أزاح الفجر الليل يزيح الله عزوجل قوى الشرك والظلم من أمام النبي الكريم ومن وجه الدعوة الجديدة, ويقسم بليال عشر كان لها دور في إفناء أقوى قوتين وجدا على وجه الأرض, فإذا كان الله قد أهلك عادا وثمودا فهو كذلك قادر على إهلاك المعاندين للرسول
ويقسم كذلك بعملية الزيادة والإنقاص والتي بها وفيها يهلك الناس , ثم يختم بالقسم بسير الليل وفيه إشارة إلى حتمية وجود الليل فالليل حتما لا بد أن يأتي ولكن الليل لا يأتي فيبقى, فهذا ما لا يكون, بل الليل يأتي ويزول, لم؟ لأنه يسر, فهو في دورة وحتما بعد أن يسر الليل لا بد أن يأتي الفجر وبعد الفجر يكون حتما النهار وعلو الدين الجديد!
فالله يبشر نبيه أن دينه في علو وظهور فلقد أتى الفجر وإذا أتى الفج رفحتما لا بد أن ينقضي ويذهب وبعد الفجر يكون النهار وهو ما كان فعلا, فذهب الليل وأتى فجر الإسلام وضحاه وظهره!
ونلاحظ في المقسمات بها أدلة دامغة على كون الله عزوجل بالمرصاد في الدنيا, فالمقسمات بها هي أزمنة “فجر, ليال, سير ليل” وكذلك هي فعل يحدث في هذه الأزمنة وهو عملية الشفع والوتر, فالله يشفع الناس ويوترهم في زمان, فهذا الفعل لا يحدث خارج نطاق الزمان بل هو يحدث داخله ويحتاج إلى زمان قد يطول
لذا فعلى الإنسان ألا يتعجل ويعلم أن كل شيء بمقدار وأجل والله عزوجل هو الأعلم بالزمان والمكان والقدر المناسبين لإنفاذ فعله العظيم, فإذا جاء هذا الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون!
إذا فكما رأينا من خلال هذه المعان العظيمة المرتبطة ببعضها والمرتبطة بالمقسم عليه وبالأدلة على المقسم عليه, وكذلك بكل السورة –كما سنرى بإذن الله وعونه- فمن المنطقي أن تأتي الآية التالية فتقول “هل في ذلك قسم لذي حجر”
والحجر معروف وهو كما جاء في المقاييس:
” الحاء والجيم والراء أصل واحد مطَّرد، وهو المنْع والإحاطة على الشيء. فالحَجْر حَجْر الإنسان، وقد تكسر حاؤه.
ويقال حَجَر الحاكمُ على السَّفيه حَجْراً؛ وذلك منْعُه إيَّاه من التصرُّف في ماله.
والعَقْل يسمَّى حِجْراً لأنّه يمنع من إتيانِ ما لا ينبغي، كما سُمِّي عَقْلاً تشبيهاً بالعِقال. قال الله تعالى:
هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ [الفجر 5. والحَجَر معروف، وأحسَِب أنَّ البابَ كلَّه محمولٌ عليه ومأخوذ منه، لشدَّته وصلابته. ………… والحاجرُ: ما يُمْسك الماءَ من مكانٍ منْهَبِط، وجمعه حُجْرانٌ. وحَجْرة القوم: ناحية دارهم وهي حِماهُم. والحُجْرة من الأبنية معروفة.
وحجَّر القَمَرُ، إذا صارت حولَه دارةٌ.ومما يشتقُّ من هذا قولهم: حَجَّرْتُ عينَ البعير، إذا وسمْتَ حولَها بميسمٍ مستدير. ومَحْجِر العَين: ما يدور بها، وهو الذي يظهر من النِّقاب. والحِجْر مَكَّة، هو المُدَار بالبيت. والحِجْر القرابة.
والقياس فيها قياس الباب؛ لأنها ذِمامٌ وذِمارٌ يُحمَى ويُحفَظ.” اهـ
إذا فالحجر هو العقل, ولكن نتوقف مع كلمة الحجر, فلم قال الله عزوجل هنا “لذي حجر”, ففي هذا الموضع الوحيد من القرآن أتت هذه الكلمة بهذا المعنى, وبخلاف ذلك نجد الله عزوجل يقول: ” لأولي الألباب, لأولي النهى” , فما المناسبة لاستعمال هذه الكلمة هنا؟
الناظر والمدقق في السورة يجد أن هذه الكلمة هي أنسب كلمة تستعمل في هذا السياق, فإذا نحن نظرنا بعد آيات قليلات سنجد أن الله تعالى يقول ” وثمود الذين جابوا الصخر بالواد”, وثمود هؤلاء سماهم القرآن في سورة أخرى “أصحاب الحجر”, فقال تعالى “ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ [الحجر : 80]”
والحجر واد بين الحجاز والشام كانوا يسكنونه ، قال الراغب : يسمى ما أحيط به الحجارة ِحجراً وبه سمى حِجر الكعبة وديار ثمود. إذا فالحجر أساسا يدل على الإحاطة والمنع كما جاء في قوله تعالى:
“وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ [الأنعام : 138]” وكما قال:
“وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً [الفرقان : 53]”
ولكنه يطلق تخصيصا على ما أحيط بالحجارة, فإذا نحن نظرنا في الآيات التاليات وجدنا أن الحجارة كانت هي العامل المشترك لهذه الأقوام المذكورة والتي اغتروا بها. فعاد التي كانت في اليمن بنت من الأبنية العظيمة ما لا يقارن به, حتى أن الله قال في حقهم ” أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ [الشعراء : 128]”
وبداهة هذه الأبنية كانت من الحجارة وأما ثمود فوصفهم الله بذلك هنا وفي الأعراق “جابوا الصخر بالواد” “وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ [الأعراف : 74]”
والحضارة المصرية القديمة اشتهرت أيما اشتهار باستعمال الأحجار, وفرعون كان عظيما من ملوك مصر القدامى –الموصومين زورا وبهتانا بالفراعنة, وما كان فيهم إلا فرعون واحد هو فرعون موسى!-.
إذا فالعامل المشترك بين الأقوام الثلاثة هو القوة الشديدة واستعمال الحجارة, فالله تعالى يقول: “هل في ذلك قسم لذي حجر” لإنسان لديه عقل قوي يمنعه من الهلاك والضياع حتى لا يكون مثل هؤلاء الأقوام الذين لم يتمنعهم حجارتهم من الهلاك!
ومن الممكن القول أن في الآية كذلك إشارة إلى المتكبرين والطاغين, فيمكن أن تفهم بأن هل في ذلك السابق قسم لمن يحتمي بقوته وبمن يمنعه فيحسب أن هذا حجر له ومانع, كما فعل عاد من قبله فقالوا ” فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ [فصلت : 15]”,
فينبهه الله عزوجل أن تبدل الأزمنة ومرورها والنقصان والزيادة أكثر من كافية لإهلاك أي طاغ متجبر محتم بغيره, فدورة الزمان دائرة وهي لا تبقي أحدا!
إذا فكما رأيت عزيزي القارئ فإن في هذه الأقسام إشارات جليلة عجيبة تزلزل وتؤثر في كل إنسان ذي حجر! فإذا نحن انتقلنا إلى باقي الآيات فسيكون التناول يسيرا سريعا لأن الرابط العام للسورة قد ظهر للقارئ.
وبعد أن أنهى الله عزوجل الأقسام يقول مخاطبا النبي الكريم ” ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد”
فالله يسأل نبيه ليذكره بقدرته ورصده, ألم تر –وبإذن الله سنفرد موضوعا مستقلا لمسألة “ألم تر” هذه- كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد والتي وصفها الله في كتابه الكريم أوصافا عدة توضح عظمتها , ذكرنا نحن بعضها في أثناء عرضنا, ويزيدها هنا فيقول “التي لم يخلق مثلها في البلاد” وسواء كان المراد من “مثلها” المدينة نفسها أو القبيلة نفسها كما قال الله تعالى:
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الأعراف : 69]
فالشاهد أن الله قد أهلك هؤلاء القوم الذين قزادهم بسطة حتى قالوا من أشد منا قوة! فأنزل عليهم العذاب بالريح فبادوا!
وكذلك “وثمود الذين جابوا الصخر بالواد” أي ألم تر كيف فعل الله بثمود الذين جابوا الصخر أي خرقوا ونحتوا وليس بالمعنى العامي “أحضر” فجوب كما جاء في المقاييس:
” الجيم والواو والباء أصلٌ واحد، وهو خَرْقُ الشيء. يقال جُبْتُ الأرضَ جَوْبا، فأنا جائبٌ وجَوّابٌ. قال الجعدي:
أتاك أبو ليلى يَجوبُ به الدُّجَى دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُويقال:”هل عِندك جَائِبةُ خبرٍ” أي خبرٌ يجوب البلاد.
والجَوْبَةُ كالغائط؛ وهو من الباب؛ لأنه كالخَرْق في الأرض.
والجوْب: دِرعٌ تلبسُه المرأة، وهو مَجُوبٌ سمِّي بالمَصدر.
والمجِْوَبُ: حديدةٌ يُجابُ بها، أي يُخْصَف. وأصلٌ آخر، وهو مراجَعة الكلام، يقال كلمه فأجابَه جَواباً، وقد تجاوَبا مُجاوَبة.” اهـ
فهؤلاء كانوا من الأقوام الشديدة وكانوا يعيشون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم ولكن على الرغم من ذلك أهلكهم الله بالصاعقة!
وكذلك فعل الله بفرعون ذي الأوتاد! ونلاحظ هنا أن الله عزوجل عندما تكلم عن هلاك فرعون تكلم عن هلاكه هو –وآله تباعا- وليس عن هلاك وتدمير الحضارة المصرية! لأن العذاب الذي خصص لفرعون كان عذابا مسلطا على أفراد وليس على المباني كما كان مع عاد وثمود!-
إذا فالله تعالى يسأل النبي الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود وفرعون, وهم من كانوا في القوة والمنعة ولكن كل ذلك لم يمنعهم من الله, ثم يوضح الله عزوجل للنبي الكريم السبب الذي أدى إلى نزول العذاب بهم, فالعذاب لا ينزل هكذا اعتباطا وإنما لأسباب حازمة فقال: “ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد” فلقد طغت هؤلاء الأقوام طغيانا عظيما وأكثروا الفساد في الأرض فأرسل الله عزوجل لهم الرسل فاستمروا في طغيانهم ولم يرتدعوا أو يتذكروا “فصب عليهم ربك سوط عذاب”
والصب هو النزول المتوال ولقد صب عليهم الله عزوجل سوط عذاب ولم يصب عليهم العذاب! فالعذاب الحقيقي والصب الحقيقي سيكون في الآخرة! أما في الدنيا فمجرد سوط, والسوط كما جاء في المقاييس:
“السين والواو والطاء أصلٌ يدلُّ على مخالطة الشَّيءِ الشيءَ. يقال سُطت الشّيءَ: خلطتُ بعضَهُ ببعض. وسَوَّط فلانٌ أمرَهُ تسويطاً، إذا خَلَطَه. قال الشَّاعر:
فلستَ على تسويطها بمُعان
ومن الباب السَّوط، لأنّه يُخالِط الجِلدة؛ يقال سُطْتُهُ بالسَّوط: ضربتُهُ.
وأمَّا قولهم في تسمية النَّصيب سَوطاً فهو من هذا. قال الله جلَّ ثناؤه: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ [الفجر 13]، أي نَصيباً من العذاب.” اهـ
أي أن العذاب الذي نزل بهم لم ينزل صافيا بل كان مخلوطا, فما بالنا بالعذاب الذي سينزل يوم القيامة! –وقنا الله وإياكم شره وحره-, ولقد نزل هذا العذاب بعدما طغوا وتجبروا وتكبروا لأن ” إن ربك لبالمرصاد“. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالله عزوجل بالمرصاد وهو مفعال من الرصد وهو بمعنى المراقبة والتهيئ والإعداد وكما جاء في المقاييس:
“الراء والصاد والدال أصلٌ واحد، وهو التهيُّؤُ لِرِقْبةِ شيءٍ على مَسْلكِه، ثم يُحمَل عليه ما يشاكلُه. يقال أرصدتُ لـه كذا، أي هيّأْتُه* له، كأنّك جعلتَه على مَرصَده. وفي الحديث: “إلاّ أنْ أُرْصِدَه لدَيْنٍ عَلَيّ” وقال الكسائيّ: رصدتُه أرصُدُه، أي ترقَّبتُه؛ وأرصَدْت لـه، أي أعدَدْت…. ” اهـ
إذا فالله راقب لأفعال العباد معد لهم –في الدنيا والآخرة- ما يناسبها من الثواب والعقاب, وقد يتأخر هذا الجزاء ثوابا أو عقابا ولكنه نازل نازل لأن الله تعالى بالمرصاد.
ثم ينتقل الله عزوجل ليوضح للإنسان أنه غافل عما ذكره الله عزوجل في أول السورة وكيف أنه ينسى أن الله عزوجل بالمرصاد وليست العبرة بالقريب وإنما العبرة بما يؤول إليه الإنسان –أو الأمة كلها- فهذا هو الجزاء الحقيقي الباقي! فيقول: “فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) “
فيوضح الله عزوجل أن عملية الشفع والوتر التي ذكرها في أول السورة هي من الابتلاء الذي ينزل بالناس أمما وأفرادا لعلهم يحمدون أو يتضرعون ولكنهم ينسون! فيقول: “ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ….” فالإعطاء والإكرام والتنعيم هو ابتلاء من الله عزوجل لينظر أيشكر أم يكفر ” …….. قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ [النمل : 40]”
فيظن الإنسان أن الله عزوجل بعطائه إياه فإنه راض عنه وأن الله عزوجل أكرمه “ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ [سبأ : 35]“
فيظن الإنسان أن عطاء الله دليل على الرضا والإكرام وإذا حدث وكان هناك بعث فسيكون هناك كذلك من الفائزين ” وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً [الكهف : 36]”
فينسى الإنسان شكر الله ويكفره! وإذا حدث الابتلاء بالشكل المغاير وكان الابتلاء بتقدير الرزق –ولا يشترط في تقدير الرزق تضييقه , بل قد يكون لدى الإنسان ما يكفيه ولكنه ينظر إلى من فتح الله لهم في الرزق!-
فيظن أن في هذا إهانة من الله عزوجل له! فيرد الله عزوجل على هذين الظنين الباطلين ويوضح أن الإكرام والمهانة أو توسيع الرزق وتضييقه راجع كذلك إلى بعض العوامل في مجتمع الإنسان – والمراد من الإنسان في الآية جنس الإنسان وعامته بدليل الانتقال من المفرد إلى الجمع “تكرمون, تحاضون ….” –
فإذا أتى الناس بهذه الأفعال قٌدّر عليهم في أرزاقهم وظهر فيهم الفساد الذي يؤدي إلى إهلاكهم, -وبداهة إذا أتوا بمعكوسها فينصلح حالهم ويفوزوا في الدنيا , وإذا كانوا من المؤمنين فازوا في الدارين- ويكونوا هم بهذا هم الذين أهانوا أنفسهم! وهذه الأفعال هي: ” كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) “
فإذا كان في المجتمع إهمال لمن مات أبوه وتضييع له, وعدم اهتمام بالضعفة المساكين وكذلك هناك أكل تام شامل للتركات وتضييع لأصحابها وكذلك تكالب على جمع المال وحب شديد له يلهي عن غيره فهنا ينزل حتما العذاب بذلك الإنسان اللاهي الغافل , وهنا تكون الإهانة الحقيقية , فليست الإهانة في تقدير الرزق وإنما الإهانة عند تحقق هذه العناصر في المجتمع, فإذا تحققت ظهر الفساد وعمت الأثرة في المجتمع وغلب الحقد والتشاحن بين الأفراد فيقودهم هذا إلى المهانة وإلى الهلاك!
ثم يقول الله عزوجل مرة أخرى ” كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) ” فيوضح للإنسان بقوله “كلا” أن ما في الدنيا ليس هو الإكرام والإهانة وإنما يكون الإكرام والإهانة الحقيقيين في الآخرة, فكل ما في الدنيا هو خلط أوجزاء بسيطة فإذا جاءت الآخرة كان الأصل والدوام. ف ” إذا دكت الأرض دكا دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23)”
ونلاحظ أن هذه هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها “جاء” لله عزوجل, فلم يذكر مجيء أو ذهاب لله عزوجل في القرآن كله! ونلاحظ أن الله جاء والملائكة صفا صفا وكذلك “جيء يومئذ بجهنم” فجهنم كذلك موجودة في المشهد! فلماذا جاء الله عزوجل؟
لأن الله تعالى بالمرصاد في الدنيا وهناك الكثير ممن يرون فعله ينكرون أن يكون موجودا فيجيء الله عزوجل في اليوم الآخر بشكل هو وحده أعلم به! (ونلاحظ أنه جاء وليس أتى فتنبه!) فيحاسب العباد الحساب التام الكلي على أفعالهم فيجازيهم عليها بالعدل فلا يظلم أحد شيئا.
إذا فلدينا مشهد يجتمع الله عزوجل فيه هو والملائكة وجهنم , وهنا علينا أن نتذكر أن جهنم هي مرصاد! ” إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً [النبأ : 21]”
فجهنم مرصاد والله عزوجل بالمرصاد, ولكن جهنم “للطاغين مآبا” فهي مرجع الطاغين أما المؤمنين فمرجعهم إلى الله عزوجل ورحمته وجنته!
فإذا جيء بجهنم يتذكر الإنسان –ونرجو أن يكون القارئ متذكرا لما طلبنا إليه الانتباه إليه عند حديثنا عن النسيان!- ولكن أنى له الذكرى, فلا فائدة من هذه الذكرى في هذا اليوم فلقد ذكّر الأنبياء في الدنيا ولكن لا سميع ولا مجيب! ولكن كان هناك ضغيان وفساد وإنشغال بالأرض!
فهناك يندم الكافر فيقول “يا ليتني قدمت لحياتي” أي يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي الحقيقية لأن الحياة الدنيوية مهما طالت فهي منقطعة وزائلة أما حياة الآخرة فهي الباقية لذلك فهي الحيوان ” وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [العنكبوت : 64]” فهي الحياة الباقية, فيتمنى أن يكون قدم لها ما ينجو به! ورأيت في تفسير الفخر الرازي احتمالا آخر جميلا نذكره:
” وثانيها : أنه تعالى قال في حق الكافر : { وَيَأْتِيهِ الموت مِن كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ } [ إبراهيم : 17 ] وقال : { فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يحيى } [ طه : 74 ] وقال : { وَيَتَجَنَّبُهَا الأشقى * الذى يَصْلَى النار الكبرى * ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يحيى } [ الأعلى : 11 – 13 ] فهذه الآية دلت على أن أهل النار في الآخرة كأنه لا حياة لهم ، والمعنى فياليتني قدمت عملاً يوجب نجاتي من النار حتى أكون من الأحياء .” اهـ
فالمعنى وإن كان بعيدا –لكونه من الصعب أن يكون الكافر أو العاصي قد علم ما ذكره الله في كتابه بخصوص هذا الأمر, فكثير من المسلمين يغفلون عن هذه الآيات!- ولكنه جيد فنثبته!
ففي هذا اليوم يكون العذاب شديدا جدا ويكون عذابا مباشرا لا ينتظر زمانا أو يحتاج إلى عوامل أو تدخل من أحد ” فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26)”, فكما وضحنا فالإنسان يكون من الأسباب التي تؤدي إلى نزول العذاب به وبقومه في الدنيا فيكون هو بفعله من عذب نفسه –راجع العناصر التي عاب الله عزوجل على البشر فعلهم لها في السورة!-
أما في الآخرة فليست هناك تداخلات أو أسباب أو ما شابه فالأمر كله لله فهو الذي يعذب وهو الذي يوثق! ولكن ليس هذا التعذيب لكل إنسان, وإنما هو لمن أهان نفسه أما من اتبع رضوان الله عزوجل, فله جزاء ومرجع آخران وهو ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28)”
والمراد من الرب هنا حتما هو الله عزوجل وليس بدن الإنسان كما قال بعض المفسرين, لأن الناظر في كتاب الله عزوجل يجد أن الله تعالى يقول: ” ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [الأنعام : 164] , قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ [السجدة : 11] , ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [الزمر : 7] , إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ [القيامة : 12], إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ [القيامة : 30] “
وكثير من الآيات المشابهة, وهي كله تدور في فلك إثبات معنى رجوع الإنسان إلى ربه, فكذلك هنا هذه الآية!
فالنفس المطمئنة بذكر الله عزوجل وبدينه وكتابه ترجع إلى الله راضية بفعل الله وقضائه في الدنيا وبثوابه في الآخرة, “فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)” فتنضم النفس المطمئنة إلى باقي عباد الله عزوجل وتدخل جنة الله عزوجل. فهناك كانت جهنم مرصاد للطاغين مآبا, وهنا الجنة مرجع المتقين ففيها نعيم الله عزوجل.
فانظر أخي في الله إلى تلك السورة العظيمة التي قدمت تصورا بديعا لمراقبة الله عزوجل لعباده ولمحاسبته لهم وإعداده لهم في الدنيا والآخرة ما يستحقون وإنزاله في الوقت المناسب, وكيف أن السورة من أولها إلى آخرها تثبت أن الله عزوجل يحاسب الناس على ما قدمته أيديهم فلا يظلمهم وكيف أنهم هم الذين يظلمون أنفسهم فينزلون العذاب والهلاك بأنفسهم في الدنيا ثم يكون مآلهم في الآخرة إلى النار, أما الطائع المتقي فيُكرم في الدنيا ويكون مرجعه إلى جنة الله ورحمته في الآخرة, جعلنا الله وإياكم من أصحابها!
والسلام عليكم ورحمة الله!
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد