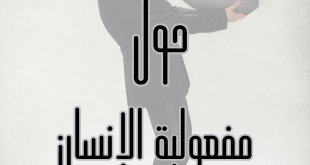تقول الحكمة حين يكثر الكلام عن أمر ما ؛اعرف أنه غائب : كثر الكلام عن ضرورة الاجتهاد و ان بابه أغلق فهناك من يرى ان الاجتهاد أعلن وفاته بحلول القرن الرابع بعد تشكل المذاهب المختلفة و لابد من إجتهاد عصري كى نلحق ب مستجدات العصر و غيرها من الشقشقات المتهالكة التي يتعارك عليها الناس في أخر قرنين. في الحقيقة أريد أن أصدم القارئ بأن الاجتهاد في الشريعة او عدم الاجتهاد فيها سيان! لأن العالم الاسلامي ليس حرا ل يطبق او لا يطبق الشريعة: هذا ان اتفق المسلمون عن تحديد الشريعة و مقاصدها و أوجدوا آليات لتطبيقها في واقع هم خارجه و ليس لهم يد في صنعه، فمع انهيار الحضارة الإسلامية و منتجاتها الفقهية و العلمية بل و حتى الإدارية في شكل الإمبراطوريات الحاكمة خرج المسلمون من التاريخ و لم يعودوا حتى الأن.
لذا الكلام عن الشريعة و الاجتهاد يتطلب اولا الحرية ثانيا القدرة على التحكم في الواقع و هذا يخضع ل موازين القوى و نتيجة الاستقالة العقلية التي دخلها العالم الاسلامي منذ قرون و الغياب الحضاري فالكلام عن الاجتهاد و الشريعة عبث، و لكن حتى يعود المسلمون الى التاريخ مرة الأخرى من الممكن أن نرسم ملامح كلية افتراضية لمرحلة اعدادية تأهيلية حين تستعيد الأمة عافيتها و يأذن الله لها بالعودة الى التفاعل مع الواقع والتاريخ يمكن القول أن هناك مقدمات لازمة لاعادة بناء المفاهيم والتصورات عن الشريعة الواجبة و الواقع المعيش كى نرسم البديل اذا سنحت الفرصة التاريخية بالإنعتاق. أولا لابد أن نحدد ماهية الشرع و مصدره و هل هو مصدر ام مصادر ثم كيف نتعامل مع هذا المصدر او المصادر، فذا قلنا أن الوحى هو مصدر الشريعة و أساسها فكيف نتعامل معه و ما علاقته بالواقع هل هى علاقة تفاعلية ام علاقة اسقاطية اننا نسقطه اياته على الواقع او العكس؟ و تلك الأمور نوقشت في تراث المسلمين الضخم خاصا في علم أصول الفقه و ان هناك عصفا ذهنيا كبيرا و تركت الأسئلة مفتوحة حتى يومنا هذا عن القرأن و لغته و هل فيه نسخ و السنة و تعريفها و هل هى تنسخ القرأن أم تابعة له و كان لهذا عدم الحسم عواقب وخيمة على الأمة الاسلامية خاصا بعد جمود و تكلس هذا العلم بحلول القرن السادس الهجري تقريبا.
فوجدنا أن مصادر الشريعة تعددت و تفرعت فبعد القرأن و السنة دود تحديد دقيق لمعنى الخير زاد الأصوليون الاجماع، و القياس، و الاستحسان ،و الاستصحاب، شرع من قبلنا رغم مخالفة العنصر الأخير لنص القرأن” أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّۢ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ” ( المائدة) و وصلت الأصول فوق الخمسين و العجيب انهم وضعوا شروطا للاجتهاد بناءا على أمور غير محددة و بعضها مختلف عليه : ف المجتهد المطلق لابد ان يكون عالم بالقرأن او حافظا له دون ان يقول باى مقاربة يتعامل مع النص و لغته ! و ان يكون هذا المجتهد عالما ب الناسخ و المنسوخ و مسألة النسخ خلافية أصلا ثم قالو ان يكون ملما بالسنة دون تحديد ل معناها التي تختلف تعريفها عند أهل كل تخصص من اهل العلوم الشرعية و كذا الأمر في الإجماع و القياس فالقياس أحيانا لا يراعي اختلاف التحولات النوعية في التاريخ و جعل العقل المسلم يريد دائما ان يقلد و يقيس شيء على شيء و هذا ظهر مع غزو الحداثة أصبح الفقيه يجد نوازل لايجدها في الكتب الفقهية او نص مباشر في القرأن او الحديث النبوي كلها امور بها مشكلات منهجية و تاريخية و اعتبروها مسلمات و مقدمات حتى جاء الجويني ليقول لنا في القرن الخامس عن فتور الشرائع و غياب المجتهد في كتابه الغياثي، ثم كتب تلميذه الامام أبو حامد الغزالي كتابه الشهير أحياء علوم الدين فالرجل و هو العقل الفذ اعتبر علوم الدين ميتة و هو المتوفى505هجريا فهذا هو حال علم الأصول الذي كان الهدف من تأسيسه وضع قواعد تعصم ذهن المجتهد من الوقوع في الخطأ فكيف نجد ان التقليد في الاصول ظل السمت القائم بعد القرن السادس الهجري و جل ما كتب تكرار او إضافات غير جوهرية
. كل ما سبق شتت الذهن المسلم و و اصبح عقله عقل ذري يتعاطى مع الجزئيات دون رؤية كلية. مما أنحرف بالفقه في البحث عن الحكم الشرعي في مسائل جزئية و فرعية دون البحث عن مقاصد الحكم الشرعي في
المنظومة الكيلة للقران و كيفية تفعيلها في المجتمع، و لكن تلك المرحلة المتقدمة كان للمسلمين امبراطورية و حاكم يكسب شرعيته كخليفة لخلفاء رسول الله ص فكان هناك ارادة و حرية للتطبيق و للفقيه مساحة أوسع للابداع ستختفي مع ظهور الدولة القومية الحديثة التي أتت بنظم من خارج النسق الاسلامي أصلا و لا تعترف بمرجعية الوحى لكن بحكم تجذر الإسلام تاريخيا و مجتمعيا فلابد من عملية تحلة أو التفاف اضفاء الشرعية على نظم غريبة من خلال دمج الفقيه كموظف في دولاب الدولة القومية الغربية الحديثة.
لذا دخل العالم الاسلامي المرتخي المخترق غربيا على عالم الحداثة كأهل الكهف من ناموا لقرون و أفاقوا على عالم أخر دون حل الكثير من المشكلات المنهجية في التراث التي لم تك ظاهرة في ظل التفوق الحضاري و الامبراطوري كما أن السلطان كان يرجح المذهب الواجب اتباعه حين الخلاف مع استقرار المجتمع على أعراف معينة فكان الاجتهاد الفرعي على مستوى فتوى الأفراد و جل النزاعات القضائية قائم في أمة مترامية الأطراف من مالي غربا الى سيبيريا و الصين شرقا لكن تلك المنتجات الفقهية و الأصولية ب حلوها و ب مرها بنجاحاتها و إخفاقاتها , انتجت في عصر مختلف تماما عما نعيشه الأن فالتعامل و النقل من هذا التراث كما يحدث في المدارس التقليدية بقراءات خارج السياق أدت لخروج تلك العلوم من واقع المجتمعات لانها جمعت بين الجهل بالتطور النوعي للواقع الحداثي الغربي ! فضلا عن عدم فهم التراث و تطوره بشكل دقيق و خلطه بشريعة .
بناءا على ما سبق لابد من حل منهجي لاعادة بناء المنظومة المعرفية الشرعية اولا: مركزية القرأن و ،هى فكرة أشار لها الاصول و المفكر الدكتور طه جابر العلواني، ككتاب مهيمن و مصدق على ما دونه سواء كانت منتجا تراثيا أو حداثيا، ثانيا التامل مع القرأن الكريم كوحدة واحدة لا ك آيات مفتتة: بها مكي و مدني و ناسخ و منسوخ، منتزعة من سياقه و رؤيته الكونية : التي هى رؤية اخلاقية معيارية متجاوزة للزمان و المكان تؤسس للتوحيد و تزكية النفس، عمران الكون و تحقيق العدل و بالطبع تلك المقاصد لا تتحقق بلا شرط اساسي و هى الحرية في الاعتقاد و الفهم و البحث و من ثم التطبيق. لذا فاى عمل فرعي يدخل تحت تلك الكليات المقاصدية فاى فهم تفسير او فتوى تخرج عن تلك المقاصد فهى اشارة ب بطلانها.
الرؤية القرأنية حددت و نظمت العلاقات الأنطولوجية : الله –الانسان – الطبيعة، فالقرأن حث الانسان على النظر في الكون المسخر له بغية تحقيق العدل و عمران الأرض و هذا جلي في قولة تعالى:” هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الأرض واستعمركم فِيهَا ” (هود) و أيضا “إن الله يأمر بالعدل والإِحسان وإيتاء ذي القربى” ( النحل) لكن تلك العناصر غابت عن فقه المتأخرين و انفصلت العلوم الطبيعية و الرياضيات التي برع فيها المسلمون فيما يعرف بالجمع بين قراتين الكون و الوحى ثم في العصر الحديث تخلف المسلمون كثرا في العلوم الطبيعية و الانسانية على حد سواء ما يجعل عملية الاجتهاد في عصرنا في غاية الصعوبة بل الاستحالة. فهذا الفصل بين العلوم الشرعية و علوم الكون و فقه الانسان كما عبر، المفكر المصري الأزهري عمرو الشاعر في كتابه, أدخل المسلمين في عالم لاهوتي جبري أخرج لنا شخصية عاجزة عن التعامل و التفاعل مع الواقع لانها تنطلق من معارف كانت تخاطب زمن أخر. كما نجد التفاعل و التوازن بين عالم الغيب و عالم الشهادة بشكل سلس بعيدا عن التعقيدات الكلامية المتأثرة بالنزعة اللاهوتية المخالفة لروح الإسلام و سماحة و يسر التوحيد القرأني.
لذا يمكن تعريف الاجتهاد المطلوب في عصرنا: بأنه عملية التفاعل مع الوحى الواجب و الواقع الماثل بعد تحليل و تفكيك تفاصيله من خلال العلوم الطبيعية و الانسانية بغية تحقيق المقاصد العليا للشريعة : من توحيد و تزكية أخلاقية , عمران حضاري, و تحقيق العدل و هذا يحتاج عمل جماعي من أفراد مؤهلين لذا الاجتهاد الجديد هو مؤسسي و كما قال الشيخ طه جابر لعلواني و ليس عملا فرديا فقط بل إجتهاد أمة حسب تعبيره. يعني تلافي عيوب النظام الفقهي القديم خاصا عند المتأخرن الذي اهتم بقولبة الدين بتعريفات منطقية أرسطية و غرق في اللغة على حساب الواقع و اهتم بالشكليات على حساب المقاصد فنجد مجتمع شعائري يقدس الدين أيما تقديس لكنه لا يحقق المقصود النهائي من الأحكام الفقهية الفرعية : فرض واجب و مكروه وحرام و المباح بل أحيانا نجد ممارسات في الاتجاه المعاكس لمقاصد الشرع للأسف.
و هذا لا يعني إهمال التراث الفقهي و الأصولي أو الحديثي بل يجب العمل على مراجعته مراجعة نقدية علمية
في ظل مركزية القرأن كمرجعية نهائية فالاستفادة من الخبرات و السوابق التاريخية في هذا التراث الصخم يعطي عمقا فكريا ولا شم ستكون له ثمرة ايجابية لكن عمليات التكرار و الاجترار ستزيد عزلة هذا التراث عن الأجيال الجديدة و تزيد من تهميش تلك العلوم بل تظلمها. كما ان الاجتهاد الجديد يقوم على استقراء الظوهر و تحليها و يبدع في ايجاد الأليات لتفعيلها في الواقع دون التوقف عن صب اللعنات على الانحرافات الاجتماعية كما ذكرت أنفا أن الاجتهاد الجديد هو محاولة نسبية بشرية لتقريب الواقع من الواجب في الشرع بشكل علمي يقوم على البحث و التحليل الهادئ دون جلبة و الدخول في مهاترات و معارك وهمية بين أطراف تعاني من جهل مركب ثلاث الأبعاد: جهل بالشريعة و التراث و الواقع.
الخلاصة كل ماسبق هو أحلام و أمنيات لا تتحق الا بالانعتاق من النماذج المعرفية التي هيمنت على العقل المسلم طوعا و كرها في القرون الأخيرة بدون ثورة تحرر معرفي و ثقافي لا يمكن الكلام أصلا عن الاجتهاد او الشريعة فتحرير العقول من تقليد التراث او الحداثة و التحول الى الفهم و التحليل و التفاعل هو بداية الانطلاقة السليمة كما نزعم.
و الله أعلم.
بقلم : أحمد أمير
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد