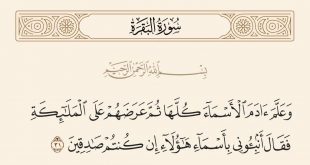المنظور العام للسورة :
إن الناظر في سورة الذاريات يجد أنها كلها تدور في فلك الآيتين ” إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع “ أي أن السورة هي من أولها إلى آخرها تأكيد لصدق وعد الله ونصرته للدين ووقوعه !
فقبلهما صورة لعملية طبيعية متصلة ممثلة في أربعة أقسام عليهما ” وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) “
وبعدها قسم آخر نابع كنتيجة منطقية لموقف المخالف و هذا القسم هو قوله تعالى ” وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُك ِ”
, ثم بعد ذلك عرض لنماذج من وقوع القسم الأول في الآخرة ثم استدلال بالطبيعة عليه ثم استدلالات تاريخية عليه تبدأ بقصة جامعة للإثنين المقسم عليهما وهي قصة المرسلين مع نوح ولوط ثم بعد ذلك إرشاد إلى كيفية التعامل مع هذا الواقع الوارد في الأقسام ثم تنتهي السورة بتوعد الكافرين بحدوث ما جاء في الآيتين المذكورتين كنتيجة منطقية لفعلهما فليس في الأمر أي مظلمة أو غبن .
ونبدأ مع السورة الكريمة : بسم الله الرحمن الرحيم
تبدأ السورة بقوله تعالى ” وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) “
اختلف المفسرون في المراد من هذه المقسمات الأربعة
فقال بعضهم أنها كلها أمر واحد وهي الرياح وهو الراجح بإذن الله تعالى , وقيل أنها مختلفات , فقيل أن الذاريات هي الرياح والحاملات هي السحب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة , وقيل أن هذا قسم تصاعدي بدأ فيه بالرياح ثم السحب ثم الكواكب ثم الملائكة , وبداهة فإن مراد الله من هذه المقسمات شيء واحد , فهل كل هذه المقسمات أمر واحد أم أمور مختلفات ؟
إذا نحن نظرنا في هذه الأقسام وجدنا أنها بدأت بالواو ثم عطفت كلها بالفاء فلم يثن الله تعالى بواو أخرى , وفي هذا دليل على أنها أوصاف أو أفعال مختلفات لشيء واحد لا أنها أشياء مختلفات ,
فإذا نحن نظرنا فيها وجدنا أن الأوصاف الواردة فيها كلها تنطبق مع موصوف واحد متغير الفعل والحال مرتبط بباقي المقسمات بها في باقي السور , فالذاريات هي المرسلات وكلاهما الرياح , والحاملات وقرا هي الرياح التي تحمل السحب والسحب هي العاديات كما وضحنا والجاريات يسرا هي الرياح كذلك والمقسمات أمرا هي الرياح وفيها إشارة إلى الملائكة . ونبدأ الآن في تناول مفردات هذه الآيات لنوضح لم قلنا أنها الرياح :
تبدأ السورة بقوله تعالى ” والذاريات ذروا “ الذاريات جمع ذارية وهي من الذرو وهي كما جاء في المقاييس :
” الذال والراء والحرف المعتل أصلان: أحدهما الشَّيءُ يُشرِف على الشَّيء ويُظِلّه ، والآخر الشَّيء يتساقط متفرّقا ً. فالذُِّروة أعْلَى السَّنامِ وغيره، والجمع ذُرىً .
والذَّرَا: كلُّ شيءٍ استترْتَ به. تقول: أنا في ظِلِّ فُلانٍ، أي ذَرَاه . اهـ
إذا فالذرو كما يتصوره الإنسان هو عملية بعثرة وإثارة وتطاير للشيء البسيط , والذي يقوم بهذا هو الرياح , فإذا نحن نظرنا في كتاب الله تعالى وجدناه يقول ” وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً [الكهف : 45] ” ,
فنخرج من هذا أن الذاريات هي الرياح والتي تذروا التراب وغيره – وليس المراد من المذري هنا التراب ولكن شيء آخر سنوضحه لاحقا –
ومما يؤكد هذا هو باقي الأوصاف الواردة فيها , فنجد أن الوصف التالي للذاريات هي الحاملات وقرا , فهذه الذاريات تحمل وقرا , والوقر معروف وهو الثقل وهو كما جاء في المقاييس :
” الواو والقاف والراء: أصلٌ يدلُّ على ثِقَل في الشَّيء. منه الوَقْرُ: الثِّقَل في الأُذُن. يقال منه: وَقِرَتْ أذنُه تَوْقَر وَقْراً. قال الكسائيّ: وُقِرَتْ أذنُه فهي موقورة. والوِقْر الحِمْل. ويقال نخلةٌ مُوقرَةٌ ومُوقِرٌ، أي ذات حَملٍ كثير. ” اهـ
فهذه الذاريات تحمل وقرا فما هو الوقر التي تحمله الرياح ؟
قال المفسرون إن المراد من الوقر هو السحاب فهذا هو الحمل الوحيد ولكن هذا جزء من المعنى وسنوضح التصور الكامل بعد سطور قلائل . فالجاريات يسرا وهذه الريح تجري بيسر وفيها يسر , واليسر معروف وهو بمعنى السهولة والليونة والخير والرخاء , ويدلل على أن الرياح تجري قوله تعالى “فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ [ص : 36] “ وكذلك قوله “ والتي تجري بأمر الله وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ [الأنبياء : 81] “
فهي تجري رخاءا ويسرا وعاصفة كل حيب مراد الله تعالى وأمره , أما من يقول أن المراد من الجاريات يسرا هي السفن فهو بعيد لأن الله تعالى لم يقسم إلا بما هو من خلقه أما ما ينشأه الإنسان فلا يقسم الله تعالى به , ثم إن هذا يقطع التناسق الموجود في هذه المقسمات والغرض من القسم بها ,
لذلك فإنا نجد أن القول الذي يقول أن المراد منها هو الكواكب أكثر رجحانا من هذا القول وإن كنا لا نقول به كذلك , فالمقسمات أمرا وهي أيضا الريح تقسم أمرا أراده الله عزوجل , ولكن ما هو هذا الأمر ؟ لم يحدد السادة المفسرون المراد من الأمر , لأنهم لم يربطوا هذه الآيات ببعضها وجعلوها منفصلات وحتى من وصلها وقال أنها كلها في الريح لم يخرج لنا صورة واحدة منها نستطيع أن ندرك منه هذا الأمر لأنه لم يقل لنا ما فائدة حرف الفاء الرابط للمقسمات بها ؟
لذا نبدأ بإذن الله تعالى في عرض الصورة التي تقدمها هذه المقسمات :
إن هذه المقسمات بها تقدم لنا صورة طبيعية واحدة وهي عملية تكون الأمطار , فالذاريات ذروا هي الرياح التي تثير الماء فيخرج منه البخار والذي يتكون منه السحاب كما قال الله تعالى ” اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [الروم : 48] “
أو تثير غيره من المواد والتي هي لازمة وضرورية من أجل تكون السحب كما قال ” وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ [فاطر : 9] “
, وبعد أن تحدث عملية الإثارة هذه عن طريق الذرو – أي تحويلها إلى ذرات , ومصطلح الذرة في القرآن لا يساوي مصطلح الذرة المعاصر كما يدعي بعض المعاصرين ولكنه يشير عامة إلى الأجزاء المتناهية في الصغر – تبدأ عملية الحمل ,
فالرياح هي التي تحمل هذه الذرات إلى أن تتجمع وتصير سحابا , فهي الحاملة لها في الحالتين , حال تكونها وصيرورتها سحابا وبعد أن صارت فعلا سحابا مرئيا للأعين , إذا فالذاريات ذرت وحملت ثم جرت يسرا أي بعد أن كونت الرياح السحب وحملته تجري به ومن دونه يسرا رخاءا حيث أراد الله عزوجل ,
فالرياح تجري يسرا بما فيه منفعة الناس ويكون فيها إشارة إلى قرب نزول المطر , لذلك يقول الله تعالى ” وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [الروم : 46] “
فالرياح تأتي بالبشرى , ثم بعد ذلك هي ” مقسمات أمرا ” فإذا نحن أدركنا الصورة التي قدمتها الآيات الماضيات عرفنا أن المراد من تقسيم الأمر هو عملية نزول المطر , فالرياح على الرغم من كونها حاملات للسحب ابتداءا مثيرات وذاريات لأصله في أول تكونه , إلا أنها كذلك هي المسببات لسقوط المطر في مرحلته الأخيرة
, كما قال الله تعالى ” وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ [الحجر : 22] “
فالرياح بما تحمله من مواد وذرات وعناصر مختلفة تلقح السحب فينزل المطر , وبهذا تكون قد قسمت أمرا وهو نزول المطر بالكم الفلاني في الوقت الفلاني على البلد الفلاني بأمر الله عزوجل وبواسطة الملائكة التي تحركها وتوجهها .
إذا فالله تعالى يقسم بعملية سقوط الأمطار من مبتدأها عن طريق الذرو بالرياح ثم الحمل ثم التسيير والجري ثم نزول الأمطار على أمرين إثنين وهما ” إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع “ , أي أن ما وعدكم الله عزوجل صادق حقيق و الصدق معروف ولقد حاول ابن فارس أن يأتي بتعريف جامع للمفردات التي تندرج تحت الصدق فقال كما جاء في المقاييس :
” الصاد والدال والقاف أصلٌ يدلُّ على قوّةٍ في الشيء قولاً وغيرَه. من ذلك الصِّدْق: خلاف الكَذِبَ، سمِّيَ لقوّته في نفسه، ولأنَّ الكذِبَ لا قُوَّة له، هو باطلٌ. ” اهـ
وهذا المدلول غير جامع بأي حال من الأحوال ولا متطابق مع المراد منه , وكعادة ابن منظور في لسانه لم يقدم معنى شاملا للصدق وإنما أخذ يقدم معنى جمل مختلفات جاء في كل منها الصدق بمعنى معين , والذي أراه أن الصدق هو بمعنى مطابقة الشيء للواقع وللغاية ,
فإذا توفر هذا العنصر الثنائي كان الشيء صادقا , وأسقط هذا المعنى على أي مفردة استعمل فيها الصدق فستجد أنها كافية لها . ونعود إلى السورة فنقول : جعل الله تعالى هنا جواب القسم “ إنما توعدون لصادق “ أي أنه لا كذب فيه فهو متطابق مع الواقع ومع الغاية وهو ما سيكون بأمر الله تعالى ,
ونلاحظ أن الله تعالى قال هنا ” إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ” وقال في سورة المرسلات “ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ [المرسلات : 7] “ فاكتفى هنا بالحديث عن صدق الوعد ووقوع الدين أما هناك فقال بوقوع الوعد نفسه , فنخرج من هذا أن سورة الذاريات هي أسبق نزولا من المرسلات
إذا فوعد الله في القرآن كله صادق فهناك بعث وحساب وعقاب , وكذلك نصر واستقواء للمسلمين ” إن الدين لواقع ” أي أن الدين سيقع ويكون فهو واقع مستمر ولن ينتهي قبل أن يتمه الله عزوجل ,
وهذه نبوءة تحققت بأمر الله , فلم يقدر أعداء الدين على أن يقطعوه أو يبيدوه أو يقتلوا رسوله لأن الله تعالى قال ” هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [الصف : 9] ” ونجد أن هذا تحقق فقال الله تعالى ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً “ .
والناظر في أقوال المفسرين يجد أن جلهم يقول أن المراد من الدين هنا هو الجزاء وليس الدين بالمعنى المألوف ويستندون في ذلك إلى الآية التالية القادمة في السورة وهي قوله تعالى “ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ [الذاريات : 12] ” فقالوا أن المراد من ” وإن الدين لواقع ” هو أن الجزاء لوقع ! مع أن هذا جاء في قوله تعالى ” إنما توعدون لواقع ” فالمشركين هم الذين وعدوا بالحساب والعقاب في الآخرة أما الرسول فهو الذي وعد بالنصرة وإتمام الدين , لذا فعلى قولهم هذا فإنه تكرار , أو عام بعد خاص كما يزعمون !
والناظر في القرآن يجد أن كلمة الدين تأتي دوما بمعنى الدين المعروف سواء جاءت معرفة أو نكرة , إلا إذا أتت في هذه التركيبة ” يوم الدين ” فيفهم أن المراد منها هو يوم من أيام اليوم الآخر , لذا فإنا نرفض أن يكون الدين هنا بمعنى الجزاء ونرى أنه بمعنى الدين .
إذا فالله تعالى يقسم بعملية تكون المطر وسقوطه والتي اشترك فيها الرياح والسحب والملائكة – وهو أجسام لها وجودها الموضوعي خارج الوعي الإنساني – أن ما توعدون لصادق مطابق للحقيقة وإن الدين لواقع . ولكن ما العلاقة بين المقسم به والمقسم عليهما ؟
العلاقة بينهما علاقة وطيدة جلية , فالله تعالى يشير للكافرين بهذه العملية أن من قدر على إرسال رياح فهيجت ذرات ضعيفات وجرت بها ثم استقوت حتى صارت سحابا ثم صارت مطرا نازلا قد يكون خفيفا فينفع أو شديدا فيضر, قادر كذلك على أن يرسل رسولا كتابا فينضم حوله المؤمنون حتى يكثروا ويصيروا قوة كبيرة تنفع غيرها أو تضره ( وتأمل مثل الرسول ومن معه في الإنجيل في آخر سورة محمد ! ) وقادر على أن يبعث ويحي ردا على من يقول : كيف يبعثنا الله بعد أن بلينا وتحللنا ؟
فيكون الرد : انظر في المطر , كيف يتكون وكيف ينشأ ! فإذا نظرت في عملية سقوط المطر ستجد فيها أكبر دليل على إمكانية عملية البعث , فالمطر يُكوّن من ذرات تجمع من ماء , وتحدث عمليات تحويل كثيرة حتى ينزل مرة أخرى على شكل مطر , ومن قدر على التجميع والتحويل قادر على تجميع البشر وبعثهم . وحاول أن تسقط الصورة الواردة في أول السورة على مسألة إحياء الموتي فستجد فيها تشابها كبيرا ! وقارن بين هذه الصورة التي قدمناها وبين العلاقة التي أظهرناها بين المقسم به والمقسم عليه وبين ما قاله الآخرون فستجد على قولنا اتصالا وتناسبا وتناسقا واضحا !
وبعد أن قدم الله عزوجل القسم والمقسم عليه يقدم للبشر النتيجة المترتبة على ذلك والمتمثلة في أمر من أوامره سنعرض له عند تناوله .
وبعد هذه الصورة الجميلة المثبتة للبعث وللنصرة للدين ينتقل الله تعالى ليعرض حال المخالفين في الدنيا والآخرة فيقول : ” والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ” فيقسم الله تعالى بالسماء ذات الحبك والحبك جمع حبيكة وهي مشتقة من الحبك وهو لفظ معروف بالنسبة للقارئ العامي ولا نزال نستعملها في أيامنا هذه , وهو كما جاء في المقاييس :
” الحاء والباء والكاف أصل منقاسٌ مطّرِد؛ وهو إحكام الشَّيء في امتدادٍ واطِّراد. يقال بعيرٌ مَحْبُوكُ القَرَى، أي قويُّه . ومن الاحتباك الاحتباء، وهو شد الإزار؛ وهو قياس الباب.وحُبُك السماء في قوله تعالى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ [الذاريات 7] ،
فقال قومٌ: ذاتِ الخَلْق الحَسن المُحْكَم. وقال آخرون : الحُبُك الطرائق، الواحدة حَبِيكة . ويراد بالطّرائِق طرائِق النُّجوم. ويقال كساءٌ مُحَبَّكٌ، أي مخطَّط. اهـ . ونحن نقول بالعامية ” فلان محبكها ” وهو استعمال صحيح .
إذا فالله تعالى يقسم بالسماء ذات الإحكام الشديد والطرائق المتعددة المتناسقة المتوافقة والتي لا تقبل الاختلاف على أنكم أيها المكذبون لفي قول مختلف بالنسبة للبعث وبالنسبة لمحمد وبالنسبة لما سيكونه هذا الدين ,
وإذا حدث الإختلاف فهو حتما قرين الظن والكذب في كل الأقوال ما عدا قول واحد , إذ لا يمكن أن يكون كل المختلفين على صواب ,
لذلك قال الله تعالى مادحا كتابه بخلوه من الخلاف والاختلاف “ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً [النساء : 82] ” , يؤفك عنه من أفك : الأفك معروف ومشهور ومن ذلك حادثة الإفك , ونزيده توضيحا فنقول : ” الهمزة والفاء والكاف أصل واحد، يدلُّ على قلب الشيء وصرْفِه عن جِهَته. يقال أُفِكَ الشَّيءُ. وأَفِكَ الرّجُلُ، إذا كذَب. والإفك الكذِب. وأفكتُ الرّجُلَ عن الشيء، إذا صرفتَه عنه. قال الله تعالى: قالُوا أَجِئْتَنا لِتأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا [الأحقاف 22] . ” اهـ
واختلف المفسرون في المراد من الأفك هنا , هل هو مدح أم ذم ؟! لذلك نجد أن الإمام الفخر الرازي يقول عند تناوله لهذه الآية :
” وفيه وجوه . أحدها : أنه مدح للمؤمنين ، أي يؤفك عن القول المختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوي . وثانيها : أنه ذم معناه يؤفك عن الرسول . ثالثها : يؤفك عن القول بالحشر . رابعها : يؤفك عن القرآن ” اهـ
وهنا نتوقف لنسأل : كيف يكون في الآية وجوه إذا كان فيها ضمير ؟! فإذا نحن نظرنا في الآية وجدناها تقول ” يؤفك عنه ” فعود الضمير هنا يحتم معنى الآية , فالضمير يعود إلى القول المختلف , فيكون المعنى يصرف عن هذا القول المختلف من صُرف ! فهل من الممكن أن يكون هذا الوصف مدحا للمؤمنين ؟!
إن الناظر في القرآن يجد أن الوصف بالأفك دوما مرتبط بالكافرين المكذبين , والله تعالى يعيب عليهم ويعجب من أفكهم هذا فيقول ” قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ [يونس : 34] ” و َيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ [الروم : 55]
” فلا يمكن أن يكون المؤمنون أبدا ممن أفك بل هم حتما الكافرون . ولكن كيف يكون الكافرون مأفوكون عن هذا القول ؟ هل تحولوا عنه ؟
لا , إن المعنى أن الكافرون المأفوكون ابتدءا يستمرون في أفكهم هذا بسبب القول المختلف , فإفكهم نابع عن القول المختلف , كما قال الله تعالى في حق سليمان ” فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ [ص : 32] “
فحب الخير نابع عن ذكر الرب وكذلك الأفك نابع عن القول المختلف . ومما يرجح أن الوصف في الكافرين قول الله تعالى مكملا وصفهم ” قتل الخراصون ” أي لعن الخراصون القائلون بالظن , والقتل أصل واسع المعنى في اللغة لا يحصر في إزهاق الروح بل يتعدى إلى الإذلال وإلى اللعن , لذلك نجد ابن فارس يقول عند تعريفه لمعنى القتل كما جاء في المقاييس :
” القاف والتاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على إذلالٍ وإماتةٍ. يقال: قتَلَهُ قَتْلاً.
والقِتْلَة الحالُ يُقْتَلُ عليها. يقال قَتَله قِتلةَ سَوء . والقَتْلة المرّة الواحدة.
ومَقاتِلُ الإنسان: المواضع التي إذا أُصِيبت قَتَله ذلك. ومن ذلك: قتلتُ الشيءَ خُبراً وعِلْماً. ” اهـ
فالله لا يلعن القائل بالظن فقط ولكن من يصبح هذا عادته بدليل استعمال صيغة المبالغة ” خراص ” حتى أنه يجادل ويفني حياته من أجل ظن ووهم , فهؤلاء يتركون الصدق المتمثل في القرآن ووعد الرحمن ويتمسكون بالخرص , لذلك قال الله تعالى لهم : ” ….. قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ [الأنعام : 148] “
قتل هؤلاء الخراصون ” الذين هم في غمرة ساهون ” فهم لا يزالون في غمرة الباطل ساهون وغافلون ثم يجادلون ويشككون في ما جاء به القرآن ف ” يسألون أيان يوم الدين ” أي أيان يوم الجزاء الذي يجزون فيه عن أعمالهم , وليس يوم الدين هو كل اليوم الآخر ولكنه اليوم الذي يجزى فيه الصالحون والطالحون عن أعمالهم ,
ونظرا لأن هؤلاء القوم ساهون غافلون مأفوكون بالدنيا فلم يرد الله تعالى على سؤالهم وإنما تعجب من سؤالهم عن هذا اليوم فقال ” يوم هم على النار يفتنون ” والفتنة معروفة المعنى وهي كما جاءت في اللسان ” جِماعُ معنى الفِتْنة الابتلاء والامْتِحانُ والاختبار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيِّدِ، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار لتنظر ما جَوْدَتُه، ودينار مَفْتُون. والفَتْنُ الإِحْراقُ،
ومن هذا قوله عز وجل: يومَ هم على النارِ يُفْتَنُونَ؛ أَي يُحْرَقون بالنار. ” اهـ فهم يفتنون بالنار حيث يقال لهم تذكيرا بقولهم : ” ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون “ لقد كنتم تستعجلون دخلوكم النار – كما قرأتها بعيني من بعض ملاحدتنا العرب العباقرة !!
– فها أنتم الآن فيها , فلقد أتى يوم الدين وكعادة القرآن يعرض الصورة المخالفة للمكذبين المجرمين فيعرض صورة المتقين فيقول ” إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين “
فلقد انتهى عهد الفتنة فلقد كانت بالنسبة لهم في الدنيا فقط “ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ [الأنبياء : 35] “
فهؤلاء انقطع بلائهم وفتنتهم عند ذوقهم الموت أما الآخرون ففتنتهم مستمرة كما استعجلوها فلم يظلمهم الله تعالى . ونلاحظ أن الله تعالى عندما قارن في سورة المرسلات قال ” إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ … إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ “
وهنا بدأ بالجنات , لأن هناك كان الموقف كما قلنا في يوم الفصل وكان المكذبون يبحثون عن الظل الواقي فبدأ نعيم أهل الجنة بالظلال , أما هنا فهم في النار يفتنون فبدأ بالجنات . ثم بدأ في ذكر بعض وجوه هذه الإحسان فقال ” كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون “ أي أنه قليلا ما كان هؤلاء يغطون في الليل في النوم فليس هؤلاء أصحاب غفلة وبالأسحار هم يستغفرون أي أنهم يستغلون السحر كله في الاستغفار , ولم ينتبه المفسرون إلى اللطيفة الموجودة هنا في استعمال حرف الباء , فقالوا أن المراد من ذلك هو ” وفي الأسحار ” ! ثم أخذوا يتفننون في إثبات أن الحروف تستعمل مكان بعضها و … ولكنهم بقولهم هذا ضيعوا المعنى , فعندما استعمل الله تعالى الباء أشار بذلك إلى أنهم يستعملون الأسحار في الاستغفار ,
أما على قول المفسرين فجعلوهم يستغفرون في بعض هذا السحر , فشتان ما بين المعنيين . ” وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ” فهم ملزمون أنفسهم بإخراح جزء من مالهم للسائل وللمحروم بغض النظر عما افترضه الله تعالى عليهم , فهم مؤدون لحق الله تعالى عليهم سواءا في الجسد أو في المال .
ثم يقول الله تعالى ” وفي الأرض آيات للموقنين “ وهنا نلاحظ أن الفخر الرازي انتبه إلى متعلق الآية هذه المرة فقال :
” وهو يحتمل وجهين . أحدهما :
أن يكون متعلقاً بقوله : { إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق * وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ * وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ }تدلهم على أن الحشر كائن كما قال تعالى : { وَمِنْ ءاياته أَنَّكَ تَرَى الأرض خاشعة } إلى أن قال : { إِنَّ الذى أحياها لمحيي الموتى } [ فصلت : 39 ] . وثانيهما : أن يكون متعلقاً بأفعال المتقين … ” اهـ
وفي القول الأول الصواب بإذن الله تعالى , فبعد أن قال الله تعالى : إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع , – واعترض في المنتصف بتذكير الناس بأحوالهم – عاد فقال : وفي الأرض آيات للموقنين : أي ليس الأمر مجرد دعوى من محمد بل هناك آيات دالة على ذلك وهي منتشرات كثيرات ظاهرات , فهي في الأرض وفي أنفسكم ” وفي أنفسكم أفلا تبصرون “
ولقد كرر الله تعالى على مسألة وضوح الأدلة فقال : ” سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت : 53] ” , ثم يقول الله تعالى ” وفي السماء رزقكم وما توعدون “
وهنا نتوقف قليلا لنسأل : ما هو المراد من هذه الآية ؟ اختلف المفسرون في مراد الله تعالى منها فقالوا أن المراد من الرزق المطر النازل من السحاب وقيل أنه مكتوب في السماء وقيل أنه تقدير الأرزاق . ولكن لقد غفلوا هنا عن تقديم المعمول عن العامل وهو قوله تعالى ” وفي السماء ” أي أن الرزق والوعد في السماء فقط ؟ فهل الرزق من السماء فقط ؟ لا , القرآن والواقع يؤيدان ذلك فنحن نرزق من غير السماء ,
لذلك قال الله تعالى ” ُقلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ [يونس : 31] ” , فنحن نرزق من السماء والأرض بنص القرآن , فما المراد من الآية إذا ؟
لكي نفهم هذه الآية لا بد من أن نربطها بالآيتين السابقتين , حيث قال الله تعالى فيهما ” وفي الأرض آيات للموقنين ” فمن أيقن يجد في الأرض آيات كافيات , ومن تشكك ففي نفسه آيات ” وفي أنفسكم أفلا تبصرون ” وهذا بداهة ليس للموقنين وإنما للشاكين المكذبين , ثم يقول الله تعالى لهم أن رزقهم وما يوعدون كلاهما في السماء فقط , ونلاحظ أنه قال ” في السماء ” وليس من السماء , أي أن الرزق يأتيكم من عند الله بواسطة وكذلك ما توعدون من العذاب هو في السماء , ثم يختم الله تعالى الصورة بقوله ” فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ”
أي ورب السماء التي فيها رزقكم وما توعدون والأرض التي فيها آيات للموقنين إنه لحق أي أن ما توعدون لحق , مثل ما أنكم تنطقون , وهنا احتار السادة المفسرون في مراد الله من هذا التشبيه , فقالوا أن المراد من ذلك تشبيه الحق بالنطق أي أنه لحق مثل نطقكم في كونكم لا تشكون في نطقكم , والذي أراه أن المراد من ذلك هو عملية النطق نفسها وليس كون النطق حقا ,
فكما أنتم تنطقون فإن ما توعدون لحق وسيكون بأمر الله تعالى ” إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس : 82] “ فما توعدون سيكون بالأمر وهو مثل ما أنكم تنطقون , فالأمر لا يحتاج إلى وقت أو إلى زمان حتى يكون بل هو أسرع من لمح البصير ” ووَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [النحل : 77] “
إذا فالمراد أن الوعد سيتحقق بأمر الله تعالى كما أنكم تنطقون .
ثم ينتقل الله تعالى فيقول للرسول الكريم ” هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ” , الملاحظ أن الله تعالى قال هناك للرسول في النازعات بعد أن ذكر له أحوال الملائكة والمكذبين عند نزول العذاب ” هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى “وقلنا أن هذه القصة كان فيها العبرة أن الله تعالى أخذ فرعون وقومه وأنزل بهم العذاب ! فما هي العبرة من هذه القصة وما هو ارتباطها بما قبلها من الآيات ؟
قلنا أن السورة كلها تدور في فلك أمرين إثنين وهما تحقق الوعد الذي يعد به الله تعالى وهو نزول العذاب وكذلك نصرة الدين ولو بعد حين وحتى ولو لم يظهر من البوادر ما يشير إلى ذلك , وكيف أن هذا الأمر يتحقق بمجرد صدوره من الله عزوجل , وهذه القصة بالذات هي أكبر مثال جامع مانع لهذين الأمرين , وتأمل معي عزيزي القارئ هذه القصة فستجد أنها توافق كل ما قلنا به , فالقصة تقول :
” هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ (37) “
ففي هذه القصة نجد أن الله تعالى يأتي للخليل إبراهيم بما لم يتوقعه , ولقد جاء هذا التحقق على الرغم من عدم وجود أي ما قد يشير إلى تحققه , فتحققت البشرى بأمر الله تعالى وبقوله للشيء كن فيكون ,
ثم نلاحظ أن الله تعالى بعد أن ذكر وقوع هذه البشرى لإبراهيم ذكر سؤاله للملائكة ” قال فما خطبكم أيها المرسلون ” ثم ذكر له رد الملائكة “ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) “
فهنا تخبر الملائكة إبراهيم بأمر الله الذي نزلوا من أجله وهو المذكور في الآيات , ونظرا لأن السورة تشير إلى حتمية تحقق وعد الله بمجرد الإخبار به بدون الحاجة إلى أي شيء ” لحق مثل ما أنكم تنطقون ” نجد أن الله تعالى في هذه السورة بالذات لا يذكر ذهاب الملائكة إلى سيدنا لوط أو المواقف التي شهدوها معه وإنما ينتقل مباشرة إلى نزول العذاب بهؤلاء القوم , فما الأمر إلى إخبار ووقوع فإذا أخبر الله تعالى به وقع لا محالة , فقال الله تعالى بعدها مباشرة ” فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ (37) “ فحكى الله تعالى فعل الملائكة المحقق لوعد الله تعالى .
إذا في هذه القصة عبرة وعظة للمكذبين , فكما تحققت البشرى مع إبراهيم بلا أسباب وتحقق الوعيد مع قوم لوط بلا فواصل فكذلك من الممكن أن يتحقق الوعيد لكم أيها المكذبون ويتحقق النصر والتمكين لدين الله تعالى , وهذا ما وقع حقا !
وبعد ذلك بدأ الله تعالى حكي بعض الأحداث المتتاليات المتواليات وهي قوله تعالى “ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ (45) “
أي وفي هؤلاء المذكورين آية بينة للذين يخافون العذاب المبين فلقد أرسلنا لهم رسلهم فكذبوهم فتحقق الوعد بهلاكهم ونصرة أنبيائنا وأتباعهم وكانوا هم الباقين , وفي تنويع المذكورين هنا إشارة إلى اختلاف الوسائل التي من الممكن أن يتحقق بها وعد الله تعالى , فليس الأمر محصورا في شيء واحد وإنما هناك أكثر من شكل فهناك غرق بالماء وهناك صاعقة وهناك ريح عقيم ,
والشاهد أنهم لما كذبوا نصر الله تعالى رسله وأهلك المكذبين فكان مصيرهم إلى النار . ثم قال الله تعالى ” وقوم من نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ” فعلاما عطف ” قوم ” حتى أنها نصبت ؟ اختلف المفسرون في المعطوف عليه فقالوا أنه معطوف على المحل ! أي ” وأهلكنا قوم نوح ” ولست أدري ما الحاجة إلى المحل وإلى التقدير , فالمعطوف عليه هو الهاء في قوله تعالى ” فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ” أي وأخذنا قوم نوح من قبل , فهذا هو مبرر النصب . والملاحظ أن عامل الهلاك في القومين واحد وهو الغرق , فلقد أغرق فرعون وقومه وكذلك قوم نوح من قبل لما كذبوا سيدنا نوح عليه السلام .
وبعد أن ذكر الله تعالى بعضا من الأدلة التاريخية على صدق ما ذكره في أول السورة انتقل إلى ذكر بعض الأدلة الطبيعية على تحقق وعده , فقال : ” وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) “
ولن نتوقف عند الإشارات العلمية الدقيقة الصحيحة في هذه الآيات فلقد أشبعها أنصار التفسير العلمي تفصيلا وتحليلا , ولكن نكتفي بأن نذكر القارئ بأن الله تعالى في سورة النازعات بعد أن ذكر قصة هلاك فرعون قال ” إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى” ثم عقب بذكر بعض الحقائق العلمية فقال ” أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها “
فالمنهج العام للسورتين واحد , وهو قسم على أمر ثم حكاية لحال الناس تجاهه ثم ذكر لدليل تاريخي يؤكده ثم انتقال لذكر أدلة طبيعية علمية عليه , فليس الأمر فوضى كما يظن بعض الظانين .
وبعد ذلك يقول الله تعالى ” ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ” , قلنا لك عزيزي القارئ في بداية حديثنا عن السورة أن ل ” إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ” متعلق , وها نحن نصل إليه الآن , فكل ما ذكره الله عزوجل في وسط هذه السورة بعد المقسم عليه هو من باب الاعتراض والحكاية والتذكير , أما التعلق الحقيقي فهو هنا ,
فالله تعالى يوضح للإنسان ما الذي ينبغي عليه أن يفعله تجاه هذا الوعد , فيقول له على لسان الرسول ” ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ” وفي الآية لطيفة عجيبة , فكما وضحنا لك أن مدار السورة على سرعة تحقق وعد الله بالسراء أو الضراء , لذلك لما قال الله تعالى لعباده ” إنما توعدون لواقع ” ودلل على ذلك وذكّر , قال لهم : ففروا إلى الله أي أسرعوا وأنقذوا أنفسكم قبل أن يأتيكم أمر الله فساعتها لن تستطيعوا الفرار أو النجاة , لذلك ليكن فراركم من الله إليه وبذلك تنجون ! ” ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين “ فالكفر مؤذن حتما بالهلاك وأنا لكم نذير مبين . ثم يوضح الله تعالى أن فعل الكافرين وعنادهم مع الرسول ليس أمرا حديثا بل هو قديم مكرور مع باقي الرسل ,
لذلك قال الله تعالى ” كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون “ ولكم فيما ذكرنا لكم من فعل فرعون وقومه مع موسى المثال السيء , فلقد قالوا مثلما قلتم , لذلك يعجب الله من هذا الفعل فيقول ” أتواصوا به ؟ ”
لا بداهة فليس الأمر مسألة تواص بل هو أمر آخر ” بل هم قوم طاغون ” أي أن طغيان الإنسان يدفعه إلى اتخاذ بعض المواقف غير المنطقية ولما لم يكن هناك تبرير منطقي للرسل غير كونهم مرسلين من عند الله تعالى , نجد أن الأقوام يقولون أنه ساحر أو مجنون !
ولأن الإسلام دين السماحة يقول الله تعالى للرسول ” فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ” فتول أيها الرسول فليس عليك أي ملامة من فعلهم وعدم إيمانهم وذكّر فما عليك إلا التذكير ” فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ [الغاشية : 21] “
ثم ينتقل الله عزوجل إلى توضيح الغرض من خلق الإنسان على وجه الأرض وإلى عدم احتياج الله إليه فيقول : ” وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) “
فيوضح أن الله تعالى خلق الإنسان من أجل غاية واحدة وهي العبادة فإذا هو لم يؤدها كان من المنطقي أن يعذبه , فليس الأمر من باب الظلم أو عدم المنطقية وإنما هو جزاء عادل لمن رفض الاختبار وأصر على تخرصاته ! فليس الخلق من أجل إكمال نقص أو سد رأب وإنما هو لغاية واحدة ,
ولقد تكفل الله تعالى للإنسان بإشباع حاجاته حتى يتفرغ لعبادته فقال له ” إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ” فهو رزاق يرزق كيف يشاء متى يشاء بعلمه وحكمته ! وهو ذو القوة فينصر من يشاء بقوته وبمتانته فليس هو إلها ضعيفا وإنما هو رزاق , فإذا أنت جعلت من مالك حق معلوم للسائل والمحروم فلا تخش شيئا فالله هو الرزاق ذو القوة المتين , وإذا كان كذلك وهو كذلك ” فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) “
أي فإن لهؤلاء الظالمين المكذبين نصيبا وحظا من العذاب , نصيبا طاغيا مهلكا مجاوزا للحد آخذا مثلما أخذ أصحابهم , فهم يستحقون ذلك فلقد تركوا سبب وجودهم فحق استئصالهم , فلا يستعجلون ويسألون ” أيان يوم الدين ” , ” فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ” فويل للكافرين من هذا اليوم الذي يوعدون , وتختم السورة بمحورها الرئيس ,وهو ” إنما توعدون لصادق ” ويوم يكون هذا الوعد ويل للكافرين المكذبين ” ويل يومئذ للمكذبين ” كما جاء في المرسلات , فالويل لهم في هذا اليوم الذي به يكذبون .
فانظر عزيزي القارئ إلى هذا النظم البديع في عرض هذه القضية وكيف يؤكد آخر السورة أولها وكيف أنها كلها سائرة على نسق واحد وهو نفس النسق الذي سارت به النازعات , نسق محكم منطقي منظم غفل عنه كثير من الغافلين , فهل القرآن مسؤول عن غفلتهم ؟
عصمنا الله من الغفلة والسهو وهدانا وهدى بنا

 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد