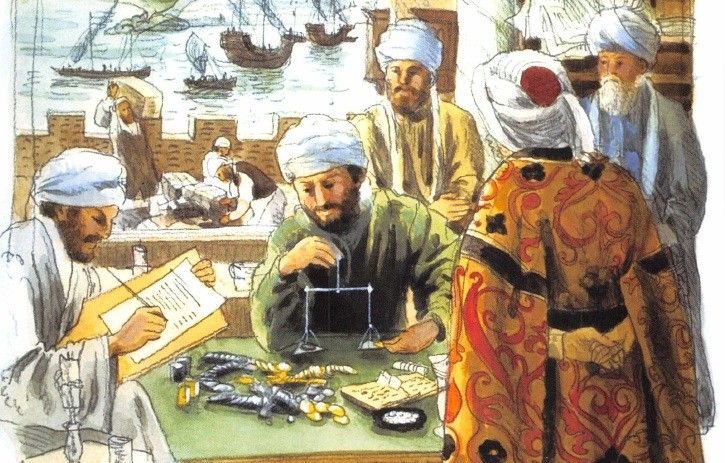ما هو التاريخ؟! … ما هو أصل هذه الكلمة, ومم اشتُقت, وماذا كانت تعني ابتداءً؟
لم تكن كلمة “تاريخ” ناهيك عن “تأريخ” مشتهرة عند العرب قبل الإسلام, ولا في زمان النبي كذلك, ومن ثَم لم تكن شائعة الاستعمال! لذلك اختلف العلماء في أصلها!
فقيل أنها غير عربية ! وأنها مما دخل العربية من لغات أخرى!
فقيل أن أصلها يرجع إلى اللغة الفارسية, وأنها أُخذت من “ماه روز” والتي تعني حساب الشهور!
وضع ما شئت من علامات التعجب! فما وجه القرب أو الشبه بين “ماه روز” وبين كلمة “تاريخ”؟!!! فثمة فارق كبير في النطق, يجعل المرء يجزم باستحالة أن تكون هذه الكلمة مُحوّرة عن تلك!
وقيل أنها أُخذت من لفظة “أرخو” الأكادية, والتي تعني: القمر, لأنه بتغير منازل القمر تتغير الأيام , ومن ثم تحدث عملية لحساب الزمان “تأريخ”.
وقيل أنها مأخوذة من العبرية, من لفظة “يرح” أو “ياريح”, والتي تعني أيضا القمر!
ويشكك الدكتور سالم أحمد محل في هذه الأقوال, فيقول:
“إضافة إلى ذلك فإن احتمال استعارة اللغة العربية لهذه الكلمة من الأكادية مستبعد، كما أن وجود الحرف (ي) في الصورة العبرية والآرامية لهذه الكلمة، يجعل الافتراض ليس محتملاً، باستعارة الكلمة من العبرية أو الآرامية.
وفي بحثه عن أصل كلمة تاريخ في العربية، يستبعد روزنثال أن تكون هذه الكلمة مأخوذة من الإثيوبية، إذ لو كانت كذلك لبقيت الكلمة في اللغة الإثيوبية لحد الآن .. كما أنه يستبعد أن تكون الكلمة قد استُعملت -أو كانت مُستعملة- في اللهجات العربية الشمالية قبل الإسلام، لعدم وجود مراكز ثقافية متقدمة في تلك الفترة، مما جعله يخلص إلى تغليب الظن باحتمال أن يكون أصلها من العربية الجنوبية.
ويرجح شاكر مصطفى أن يكون جذر الكلمة (ورخ) جذر سامي، ولكنه مأخوذ من لغة اليمن الجنوبية وليس من كلمة (يرح) أو (ياريح)، العبرية أو السريانية. (……..) ويصر العروي على عروبة مصطلح “التاريخ”، فيقول :
“إن تأليف التاريخ الإسلامي من إبداع العرب، لقد فشلت المحاولات للعثور على مؤثرات خارجية، يونانية أو فارسية، على غرار ما كشف عنه المنقبون من مؤثرات أجنبية في الفلسفة وعلم الكلام .. ليس التاريخ الإسلامي نقلاً أو اقتباسا أو استعارة من الغير .. إن كلمة (تاريخ) كلمة عربية، والكلمة الأجنبية (أسطوريا ) التي كان من الممكن استعارتها، استُعملت فعلا، لكن في معنى آخر للتعبير عن القصص الخيالية والميثولوجية التي لا تخضع لقوانين المراقبة والفحص والتدقيق، كحوادث التاريخ القريبة أو البعيدة ” اهـ
ويؤكد محمد أحمد الكامل الرأي السابق القائل بأن كلمة “تأريخ” مأخوذة من جنوب الجزيرة العربية, فيقول:
“مما تجدر الإشارة إليه أن جلال الدين السيوطي خالف شيخه الكافيجي في الرأي القائل بأن أصل التاريخ الذي أخذه المسلمون هو مُعرب عن من اللغة الفارسية، حيث تجاهل هذه الرواية وركز على الروايات, التي تؤكد أن المسلمين استمدوا التاريخ من اليمن, حيث ذكر أن أول من أرّخ الكتب يعلي بن أمية وهو باليمن، عندما كان أميراً لها في عهد عمر.
وهذا يؤكد الرأي الصحيح في الأصل الذي استمد منه المسلمون فكرة التاريخ لتحديد أوقات الأحداث، وهو ما أُثبت من خلال النقوش اليمنية المكتوبة بخط المسند التي تستخدم لفظ التاريخ استخدامين: الأول بمعنى تحديد الوقت.
والثاني : بمعنى الأحداث التاريخية نفسها
وهذا يفصل الأمر بالتأكيد بأن كلمة “التاريخ” دخلت الثقافة الإسلامية عن اللغة اليمنية القديمة.
ويؤكد السيوطي ذلك – الأصل اليمني لكلمة تاريخ- عبر رواياته المختلفة ومنها قوله:” قال ابن أبي خيثمة: أنبأنا علي بن محمد – وهو المدائني
أنبأنا قرة ابن خالد، عن بن سيرين:
أن رجلا من المسلمين قدِم من أرض اليمن، فقال لعمر: رأيت في اليمن شيئا يسمونه (التأريخ)، يكتبون من عام كذا وشهر كذا، فقال: إن هذا لحسن، فأرخوا.” ولم يستخدم المسلمون كلمة (التاريخ) للدلالة على الأحداث ـ حسبما جاءتنا من إشارات ـ إلا في منتصف القرن الثاني للهجرة، إذ كانت كلمة (الأخبار) هي المستخدمة في هذا المعنى. بينما كان أهل اليمن قد استخدموا كلمة (أرّخ) للتعبير عن الأحداث من قبل الإسلام. ” اهـ
والمعنى اللغوي الأول للتأريخ هو: الإعلام بالوقت أو تعريف الوقت.
فعندما أقول مثلا: سافرت عند صلاة الظهر, فإنني أبيّن الوقت الذي وقع فيه الحدث, وهو وقت صلاة الظهر.
والمشتهر في بناء المصدر من هذه الكلمة هو “تأريخ”, فيقال: أرّخت تأريخا!
وهذه هي لغة قيس, ومن الممكن أن يقال: ورّخت توريخا.
وهي لغة بني تميم, وكلا الاستعمالين جائز, وإن كان الأول أكثر تداولا.
إذا وكما رأينا فإن الكلمة عربية الأصل, عربية الاستعمال, وليست مأخوذة من أي لغة أخرى! وننتقل إلى النقطة التالية, وهي: تاريخ ظهور وانتشار هذا المصطلح!
ظهور المصطلح وتطوره
على الرغم من أن مصطلح “التاريخ” تأخر ظهوره وانتشاره, إلا أن هذا لا يعني أن العرب لم يكونوا يؤرخون! فالفعل نفسه كان موجودا وإن كان بشكل مبسّط! فكان الجاهليون يعتمدون بعض الحوادث الشهيرة كنقاط قياس, يؤرخون منها, فكانوا مثلا يؤرخون من موت كعب بن لؤي، ولما وقعت حادثة الفيل الشهيرة أرّخوا منها, فكانوا يقولون مثلا: بعد عامين من عام الفيل … إلخ, وأرّخوا بغير ذلك من الحوادث الكبيرة!
وكذلك كان الحال مع المسلمين أنفسهم, فكانوا يسمون الأعوام بأكبر حوادثها, تمييزا لها عن غيرها من الأعوام, فكانوا يسمون العام الأول من الهجرة بعام الإذن, أي الإذن بالرحيل “الهجرة”, والعام الثاني للهجرة كانوا يسمونه بعام “الأمر” لنزول الأمر بالقتال فيه, …. وهكذا!
إلا أن طريقة التأريخ هذه كانت تعتريها إشكالية كبرى, وهي أن هذه الحوادث الكبيرة الشهيرة, التي تُتخذ كمبتدأ وعلامة للتأريخ تصير بالتقادم غير محددة, فعندما أقول أن حادثةً ما وقعت بعد عامين من نار إبراهيم! فإن هذا لا يعطي أي إفادة عن وقت وقوع الحادثة! لأن زمن نار إبراهيم نفسها غير معلوم!
وعلى الرغم من خطورة هذه المسألة, إلا أنها لم تكن تمثل فارقا كبيرا للعربي, وذلك لأنه لم يكن لديه أي صيرورة تاريخية ولا أي تطلع إلى التطور! ولم تكن هناك أي دولة أو مملكة حاكمة تحتاج إلى معرفة أزمان الحوادث! فالأمس مثل اليوم والغد! فما النفع الذي سيعود عليه إذا عرف وقت وقوع الحدث تحديدا؟!
إلا أن الحال اختلف كثيرا مع وجود الدولة الإسلامية وتشعب أطرافها في أنحاء البسيطة, فلم يعد نظام الحياة البسيط هذا مُجديا قبالة هذه التطورات الطارئة! وكان على المسلمين إيجاد نظم جديدة للتمكن من حسن إدارة الأمور.
وتُجمع الروايات على أن إشكالية “التأريخ” ظهرت في عهد عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ذلك العبقري الفاري!
“وذلك حين كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر, أنّه يأتينا من قِبل أمير المؤمنين كتبٌ لا ندري على أيّها نعمل, فقد قرأنا صكاً محلّه شعبان , فما ندري أي الشعبانين! أهو الماضي أم القابل.
وقيل رُفع لعمر صك محلّه شعبان, فقال: أي شعبان هذا, هو الذي نحن فيه أو الذي هو آت؟ ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم وقال: إنّ الأموال قد كثرت وما قسّمناه غير مؤقت, فكيف التوصّل إلى ما يضبط به ذلك؟
فقال له الهرمزان -وهو ملك الأهواز, وقد أُسر عند فتوح فارس وحُمل إلى عمر وأسلم على يديه- : إنّ للعجم حساباً يسمونه ماه روز, ويسندونه إلى من غلب عليهم الأكاسرة.
(فعرّبوا لفظة ماه روز، ومصدره: التاريخ واستعملوه في وجوه التصريف، ثم شرح لهم الهرمزان كيفيّة استعمال ذلك.)
فقال لهم عمر: ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتصير أوقاتهم فيما يتعاطونه من المعاملات مضبوطة.
فقال بعض من حضر من مسلمي اليهود: إنّ لنا حساباً مثله مسنداً إلى الإسكندر. فما ارتضاه الآخرون لما فيه من الطول.
وقال قوم: نكتب على تاريخ الفرس، قيل: إنّ تواريخهم غير مسندة إلى مبدأ معيّن بل كلما قام منهم ملك بتدأوا التاريخ من لدن قيامه وطرحوا ما قبله.
فاتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من لدن هجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت مبعثه صلّى الله عليه وسلّم ” اهـ
وسواءٌ ظهرت المسألة كإشكالية –كما جاء في هذه الرواية- بسبب تساؤلٍ من أبي موسى الأشعري أو من عمر نفسه, أم لم تظهر كإشكالية, وإنما كاستحسان من عمر بن الخطاب, -تبعا لروايات أخرى- عندما قص عليه قاص أن هناك شيء في اليمن اسمه “التأريخ”, أو عندما استحسن عمر بن الخطاب فعل أبي يعلى بن أمية, والذي كان عاملاً له على اليمن, وكانت كتبه تأتي عمر مُؤَرخة, -ولذا عُد أول من أرخ!- فأعجب عمر بذلك وأمر بالتأريخ!
سواء كان هذا أو ذاك, فالشاهد أن عمر هو أول من أمر بذلك, وعندما أمر بذلك واجهته الإشكالية المترتبة على ذلك, وهي بم يُؤَرخ؟ وكيف يكون العام؟
فتشاور عمر مع الصحابة حول تحديد عام يُبتدأ به تأريخ الحوادث للدولة الإسلامية, فرأى بعض الصحابة وفاة الرسول, إلا أن الرأي لم يلق قبولا لأنه تاريخ حزين, ورأى آخرون ولادته, ورأى غيرهم مبعثه!
إلا أن الرأي استقر على أن الهجرة تكون هي العام الأول في التقويم الإسلامي, لأنه لم يختلف حولها أحد, كما أنه من الممكن اعتبارها البداية الحقيقة للدولة الإسلامية, لأنها كما قال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل. بخلاف المرحلة المكية بأسرها, لذا اتخذوها كمبتدأ للتقويم الإسلامي.
وبدأ العمل بهذا التاريخ في ربيع الأول في العام السادس عشر من الهجرة النبوية المشرفة.
كما اختلفوا في كيفية ترتيب شهور هذا العام, فأراد بعضهم أن يجعل أوله شهر رمضان, لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن, وأراد آخرون أن يكون شهر ربيع الأول, لأنه الشهر الذي وُلد فيه النبي وقدم فيه إلى المدينة.
إلا أن هذا كان سيؤدي إلى أن تقع الأشهر الحرم في سنتين, فجعل عمر –ووافقه في ذلك عثمان- الشهر المحرم –والذي كان آخر السنة!- أول شهورها, لتجتمع الأشهر كلها في سنة واحدة!
وعلى الرغم من أن الكلمة بدأ استعمالها في عهد عمر بن الخطاب, إلا أنها احتاجت زمناً طويلا, حتى يُكتب لها الانتشار والعموم والاستبدال بالمصطلح القديم, كأي مصطلح جديد داخل على ثقافة المجتمع, وخاصة مع بدائية وسائل الإعلام!
وفي هذه الأثناء كان المجتمع لا يزال يستعمل المصطلحات القديمة المعتاد عليها, مثل: “الأخبار” كمصطلح دال على الحوادث نفسها, و”العد” كمصطلح دال على عملية التأريخ!
ويظهر هذا في الرواية التي أوردها الإمام البخاري في صحيح, في باب: التاريخ, من أين أرخوا, عن الصحابي سعد بن سهل:
“مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ, مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ”
فنلاحظ أن الصحابي استعمل “عد” ولم يستعمل “أرخوا” لأن هذا المصطلح لم يكن قد انتشر بعد بالقدر الكافي!
وبعد فترة من الزمان انتشرت الكلمة في المجتمع العربي وأصبحت مألوفة معروفة في الثقافة العربية, حتى أصبحت هي المصطلح العلمي المتداول, وبعد أن كانت كلمة مجهولة, استُعملت بمعانٍ عدة!
ويوجز الدكتور سالم أحمد محل التطورات التي مرت بها كلمة “التاريخ”, فيقول:
“مرت كلمة التاريخ بتطورات عديدة في ثقافتنا، فقد بدأت بمعنى التقويم والتوقيت في صدر الإسلام، واستُعملت فترة بهذا المعنى، ثم صارت بمعنى آخر وهو تسجيل الأحداث على أساس الزمن، وكان الخبر يقوم مقامها في معنى هذه العملية التاريخية، ثم أخذت كلمة التاريخ تحل محل الخبر تدريجيا، وصارت تطلق على عملية التدوين التاريخي، وعلى حفظ الأخبار، بشكل متسلسل، متصل الزمن والموضوع، للدلالة على هذا النوع الجديد من التطور في الخبر والعملية الإخبارية، منذ منتصف القرن الثاني الهجري..
ومنذ ابتداء القرن الثالث الهجري، صارت كلمة التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخباره، وأخبار الرجال، والكتب التي تحوي ذلك، وحلّت كلمة التاريخ محل كلمة الخبر والإخباري، اللتين انحطت قيمتيهما العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال في القرن الرابع الهجري.
وأصبحت كلمة (تاريخ) في العربية، تحمل خمسة معاني:
- سير الزمن والأحداث، أي التطور التاريخي، كالتاريخ الإسلامي، وتاريخ اليونان .. الخ .. The History of .
- تاريخ الرجال ..The Biography.
- عملية التدوين التاريخي، أو التاريخ، مع وصف لعملية التطور وتحليله وتقابل : Historiography.
– علم التاريخ والمعرفة به، وكتب التاريخ، ويقابل :History.
– تحديد زمن الواقعة أو الحادثة، باليوم والشهر والسنة  ate. ” اهـتعريف التاريخ
ate. ” اهـتعريف التاريخ
بعد أن تكلمنا عن أصل كلمة التاريخ ومعناها اللغوي, وعن ظهور المصطلح وتطوره, نتحول إلى التعريف الاصطلاحي للتاريخ, فما هو التاريخ؟
قبل أن نتحدث عن تعريف التاريخ, لا بد أن نذكر أن “التاريخ” يُستعمل بمعان ثلاثة:
” History كتعبير دال على مسيرة الإنسان الحضارية على سطح كوكب الأرض منذ الأزل”، وكتعبير عن “تدوين التاريخ, Historiography كتعبير عن العملية الفكرية الإنشائية, التي تحاول إعادة تسجيل وبناء وتفسير الإنسان على كوكبه “
كما أن “ثمة استخدام ثالث لمصطلح التاريخ باعتباره علماً ونظاما تعليميَّا, إذ يقول المرء مثلاً: قسم التاريخ أو أساتذة التاريخ. وهذا الاستخدام حديث جدّا في الغرب الأوربي وأمريكا “
وبداهة فإن التعريف سيكون للمعنى الثاني, المُعبِّر عن العملية الفكرية الإنشائية, التي تحاول إعادة تسجيل وتفسير الإنسان.
كالعادة لم يتفق العلماء على تقديم تعريف اصطلاحي لعلم التاريخ, فوردت تعريفات كثيرة له, فقيل أنه:
سجل ناطق بالأحداث التي عاشها الإنسان منذ أن بدأ حياته على الأرض.
وقيل أنه: ربط الأحداث بالزمن أو وضع علامات على مسيرة الزمن لتحديد وقت وقوع الأحداث كما توضع العلامات على الطريق.
وعرفه الإمام المقريزي, فقال أن التاريخ هو الإخبار عما حدث في العالم في الزمن الماضي.
إلا أن أشهر تعريفات التاريخ هو تعريف ابن خلدون, والذي يقول:
“إذ هو (التاريخ) -في ظاهره- لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول. تنمي فيها الأقوال، وتضرب فيها الأمثال، وتطرف بها الأندية إذا غّصها الاحتفال. وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال. وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال.
وفي باطنه نظرٌ وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعِلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق. ” اهـ
وكما رأينا, فالعلامة ابن خلدون أيقن أنه لا يمكن أن يقدم تعريف واحد للتاريخ, لذا اضطر إلى تقسيمه إلى ظاهر وباطن: ظاهر لا يزيد عن سرد وعرض الوقائع والأحداث! وباطن قائم على تحليل وتعليل للوقائع وأسبابها, وعد هذا من أصناف الحكمة!
ويقدم الإمام السخاوي تعريفا آخر للتاريخ, فيقول:
“التاريخ في الاصطلاح: التعريف بالوقت الذي تُضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا, مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمّة وتجديد فرض وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة، وربما يتوسع فيه لبدئ الخلق وقصص الأنبياء وغير ذلك من أمور الأمم الماضية وأحوال القيامة ومقدماتها مما سيأتي، أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف ونحوها مما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفي سماوي كجراد وكسوف وخسوف، أو أرضي كزلزال وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعون وموتان، وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام، والحاصل أنه فن يُبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثيّة التعيين والتوقيت بل عما كان في العالم ” اهـ
والناظر يجد أن الإمام السخاوي لم يفلح في أن يقدم تعريفا للتاريخ, وإنما تحدث عن ما يمكن أن يندرج تحته, لذلك وجدنا أنه يقول: “ويلتحق به … وربما يتوسع فيه”, وفي نهاية المطاف نجد أنه يجعل التعريف الاصطلاحي هو عين المعنى اللغوي, فوظيفة علم التاريخ في رأيه تحديد زمان ومكان وقوع الحادثة!!
وعندما نظر سيد قطب إلى التاريخ, أهمل تماماً جانب السرد والعرض واهتم كل الاهتمام بالتفسير والتعليل, ويعلق محمد بن صامل السلمي, على تعريف سيد قطب له, فيقول:
“وفي العصر الحديث عرفه سيد قطب بغايته, فقال:
“التاريخ ليس هو الحوادث إنما هو تفسير هذه الحوادث، واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها، وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات، متفاعلة الجزئيات، ممتدة مع الزمن والبيئة امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان.”
ولقد ركز هذا التعريف على اللب والغاية من دراسة التاريخ, وتدوين أخباره, وإلا فالحوادث والأخبار مهمة بلا شك, وهي لبنات البناء التي لا يقوم هذاالعلم بدونها.
وهذا التعريف قريب من تعريف ابن خلدون, لكن يبدو أن تعريف ابن خلدون أشمل, حيث نص على وجوب النظر في الأخبار وتحقيقها, كما أكد على النظر في العلل والأسباب, إلا أنه ينحو منحى فلسفياً. في حين أن سيد قطب كان أوضح في إدراك غاية التاريخ حسب المنظور الإسلامي.
“فالحاصل أن التاريخ علم نظري إنساني، يُبحث فيه عن حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت والتفسير والتعليل . ويشمل جانبين هما:
1- نقل الحدث بالرواية أو المشاهدة. 2- تعليله. ” اهـ
نقد مناهج التأريخ
كثيرةٌ هي كتب التاريخ التي دُونت بعد الإسلام, ويمكن تقسيمها إلى صنفين:
1- كتب عُنيت بالدرجة الأولى بتسجيل الحوادث التي وقعت في أو قبل زمان المؤرخ, وتعرضها عرضا مسلسلا من الأقدم إلى الأحدث!
بل إن بعضها قام بتقديم تاريخ لخلق الكون وخلق الإنسان وتاريخه, من سيدنا آدم عليه السلام إلى أيام المؤرخ! مثل ما فعله الإمام الطبري في كتابه: “تاريخ الرسل والملوك”
حيث تحدث عن خلق السماوات والأرض, وخلق سيدنا آدم, ثم تحدث عن الأنبياء قبل الرسول الكريم, ثم سيرة الرسول والخلفاء الراشدين بعده, ثم الدولة الأموية والعباسية, إلى أن أصبح يؤرخ لعصره في أواخر القرن الثالث الهجري!
وكذلك فعل الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: “المنتظم في تاريخ الملوك والأمم”, حيث بدء بالحديث عن بدء الخلق واستمر حتى وصل إلى أواخر القرن السادس الهجري!
وكذلك فعل الإمام ابن كثير في كتابه الشهير: “البداية والنهاية”.
2- كتب عُنيت بالدرجة الأولى بالأشخاص, فكانت تجميعا للروايات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وبالحوادث التي أحدثوها أو تعرضوا لها!
مثل الكتب التي عُنيت بالسيرة العطرة, أو جزء منها: المغازي, كما فعل: ابن إسحاق في كتابه عن النبي الكريم, والذي اختصره ابن هشام, واشتهر بعد ذلك بسيرة ابن هشام!!
ومثل كتاب الطبقات الكبير لابن سعد ( 168-230هـ) وكتاب: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري (555-630 هـ).
كما ظهر صنف آخر من الكتب عُني بالتقصي عن بعض الأفراد, وهي كتب الرجال في علم مصطلح الحديث, مثل كتاب: التاريخ الكبير للإمام البخاري.
ومن الممكن القول أن هذه الكتب كانت تعتبر “إسلامية” أكثر منها تاريخية, لأنها كانت تمثل العمود الفقري لعلم مصطلح الحديث!
والناظر في كتب كلا الصنفين يجد أن جل اهتمام مؤلفيها كان قائما على الجمع والعرض والتنسيق! ولم يعمل هؤلاء على نقد الروايات التي كانوا يقدمونها في كتبهم! فقدّموا الكثير والكثير من الخرافات, التي كانت متداولة في زمانهم, والتي يأباها العقل السليم! كما كانوا يقدمون الرواية وما يناقضها!
كما اعتمدوا التوراة وكتب أهل الكتاب كمصدر معتمد لتاريخ الزمن القديم, بل ولتفسير القصص القرآني! على الرغم من أن القرآن يقول:
” إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [النمل : 76]”
فبدلا من أن يصحح القرآن ويصبح الحاكم على كتب السابقين, أصبح متبوعا لها, وأصبحت هي التي تفسره!!!
كما لم يحاول أي منهم أن يقدم تفسيراً للحوادث ولأسباب وقوعها, والتي بتكررها تتكرر الحوادث, أو العبرة التي تُستفاد منها, ويعلق زكريا بن خليفة المحرمي, على التناول السطحي لأحداث التاريخ من قِبل المؤرخين, فيقول:
“واختلاف مناهج الكتّاب والمفكرين يرجع في جانب كبير منه إلى عدم التزام المؤرخين الإسلاميين الأوُل في عملية التدوين التاريخي المنهجية التاريخية الكلية, التي تقرأ الأحداث في سياقها الكلي, ووفق معطياتها الزمانية والمكانية وأعراف البيئة وطبائع المجتمع وفقه لحظة الحدث التاريخي, بل اقتصروا في ذلك على ما يسميه محمد عابد الجابري ب “التصور الجزيئي للزمان”
حيث قال:
(………..) فلا بد من الإشارة مع ذلك إلى أن تصور المؤرخين الإسلاميين للحدث التاريخي كان محكوما إلى حدٍّ كبير بالتصور الجزيئي للزمان كما كرّسه المتكلمون.
فالتاريخ عندهم هو (التوقيت), أي تسجيل وقت حدوث الحوادث, ولما كان الوقت في التصور البياني يقوم على الانفصال, كما بيّنا, فإن نظرة المؤرخ في الحقل المعرفي البياني لا بد أن تكون مبنية هي الأخرى على الانفصال, وبالتالي فما سيُهمه هو تعيين وقت حدوث الحادثة, وليس علاقتها بما قبلها وما بعدها, مما يجعل من التاريخ عبارة عن (فعاليات البشر في أوقات معينة) ويجعل مهمة المؤرخ منحصرة في ضبط أوقات هذه الفعاليات. وهذا ما يعكسه تصورهم للكتابة التاريخية”
وقد أشار ابن خلدون إلى تفشي هذه الظاهرة وخطورتها بالقول:
“الأخبار إذا اعتُمد فيها على مجرد النقل, ولم تُحكّم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسان, ولا قِيس الغائب منها بالشاهد, والحاضر بالذاهب, فربما لم يؤمن فيها من العثور, ومزلة القدم والحيد عن جادة الثواب, وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع, لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا وسمينا, لم يعرضوها على أصولها, ولا قاسوها بأشباهها, ولا سبروها بمقياس الحكمة …. ” اهـ
|
ونحن وإن كنا نتفق مع ما قاله الأستاذ زكريا المُحرمي, إلا إننا نأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء المؤرخين كانوا ينتمون إلى التيار الإخباري, الذي يهتم بالجمع بالدرجة الأولى, ولم يكونوا منتمين إلى تيار عقلي, مثل المعتزلة, يعمل على نقد الأخبار! كما أنهم كانوا يضعون اللبنات الأولى لعلم جديد, في مجتمع يخطو خطوات واسعة في طريق إنشاء حضارة جديدة, فشتان بين من يؤسس وبين من أتى بعد أن أصبح ثمة بناء فأصبح ينقد ويُعدِّل!
فانتقادنا المؤرخين أو العلماء القدامى لا يعني أننا نقص من قدرهم أو نعيبهم, وإنما يعني أننا ننبه القارئ أن كتاباتهم ينقصها الكثير والكثير, وأنها تحوي الغث والسمين, وأنها مجرد عرض يحتاج إلى التمحيص والتدقيق والرد!
وأنها تحتاج إلى معالجة جديدة بأسلوب علمي, يُمكِّن القارئ من الاستفادة بالمادة العلمية المعروضة فيها.
وإذا اكتفى القارئ بقراءة التاريخ من الكتب القديمة, فلن يستفيد مما قرأ إلا معرفة بعض الحوادث التي ربما وقعت في ذلك الزمان, ولن يزيد الأمر عن قراءة بعض القصص, التي يجد المرء فيها متعة وتسلية! أما أن يخرج منها بفائدة من الفوائد التي من أجلها كُتب التاريخ وقَص القرآن, فلن يكون!
لماذا ندرس التاريخ
كثيرٌ منّا يحب القراءة في كتب التاريخ, لما في عنصر التشويق, لأنها تقدم له قصصا ليست بالخيالية وإنما واقعية, حدثت في أزمان ماضية, فيُثري بذلك خياله, ويزيل بعضا من غموض ذلك الغيب, المُسمى: الماضي!
ولكن هل ندرس التاريخ من أجل هذه الإثارة وتلك اللذة؟ هل ندرسه من أجل التسلية, وإضاعة الوقت أو ملء الفراغ, ومعرفة بعض القصص التي نتفاخر بها ونقصها على غيرنا؟!
للأسف كثيرٌ يفعل هذا لذاك, ولكن هل لهذا ينبغي أن ندرس التاريخ؟
بالطبع لا, فينبغي أن نغير نظرتنا إلى التاريخ من كونه مجرد قصص وأحداث لا علاقة لها بنا ولا تؤثر فينا, وننظر إليه على أنه ذاكرتنا … نعم, ذاكرة!
فالبشرية مرت وتمر بنفس المراحل التي مر ويمر بها أي وكل إنسان, فهل يمكن لأي إنسان أن يحيى فاقد الذاكرة؟!
إن كل إنسان يستعمل ذاكرته ليتمكن من مواصلة حياته, بالبناء على ما قدّم! والذي يفقد ذاكرته يضطر للبدء من نقطة الصفر!
والمشكلة الكبرى أن عامة البشر يظنون أن لا فائدة كبيرة في التاريخ-بسبب تباعد الأزمنة-! وأن الحوادث التي وقعت في الماضي لا تؤثر في حاضرهم وليس لها أي علاقة بمستقبلهم!!
وهكذا أصبح حال البشرية مثل ذلك الإنسان الذي يظن أن ماضيه لا يؤثر فيه! وأنه يكفيه معرفة الأحداث التي مر بها في أسبوع أو شهر! ويتعمد أن ينسى ما عدا ذلك! وسواء شئنا أم أبينا فإن الماضي يؤثر في أفعالنا وفي صياغة أفكارنا وتوجهاتنا ونظرتنا إلى الآخرين, وإلى العالم من حولنا, بل وفي تطلعاتنا المستقبلية!
وليست المسألةُ مسألةَ ذاكرةٍ فحسب, وإنما خبرةٌ يكتسبها الإنسان من الأحداث التي مر بها وعايشها! فكم من الناس –وخاصة النساء- له ذاكرة حديدة, يتذكر جيدا جل ما مر به, وعلى الرغم من ذلك يعيد نفس الأخطاء والحماقات التي ارتكبها في صغره وشبابه! وذلك لأنه لم يتعلم من الخبرات السابقة, ولم يفهم المعاني التي تحتويها, ولم يعي الأسباب التي أدت إلى وقوعه فيها! لذلك يكون الجسد كهلاً, والعقل طفلا!
فالإنسان الذي فقه التجارب التي مر بها وعايشها فقد أخذ خبرة حياة واحدة محدودة, ولكنه لن يستطيع أن يتعامل وينفع ويؤثر بها لفترة طويلة, لأنه سيكون قد بلغ من العمر أرذله, أما إذا قرأ التاريخ وفقه أحداثه فسيأخذ خبرات حيوات طويلة عاشتها أجياله ممتدة من البشر, لهذا قيل:
“من قرأ (فقه) التاريخ فقد عاش الدهر كله”
وقيل: ” من حفظ التأريخ فقد أضاف أعماراً إلى عمره”
فتصور كم ستكون خبرة الإنسان, وكيف سيكون حكيما في أفعاله, ذلك الذي عاش الدهر في سنوات قصار!!
إذا, فالغاية الكبرى لدراسة التاريخ هي تواصل الأجيال البشرية وعدم فقدان الإنسان لذاكرته, وبناءه على ما قدم السابقون, ويمكن تفصيل هذه الغاية وبيانها بذكر بعض ما يندرج تحتها من الثمرات:
1- معرفة الأخطاء التي وقع فيها السابقون حتى يتمكن اللاحقون من تجنبها.
2- استخلاص الحكمة من المواقف البسيطة التي مروا بها وتنفيذها في مثيلاتها من المواقف المعقدة التي نحياها, فما هي إلاها ولكن بشكل أعقد.
3- تثبيت إيمان المؤمن بالله عز وجل, حيث يستطيع أن يرى فيه تحقق وعوده, بينما قد يموت الإنسان ولمّا يراها تقع!
4- معرفة الإنجازات الكبيرة التي أنجزها السابقون مع قلة إمكانياتهم, فنقتدي بهم!
5- اتخاذ القدوة الحسنة من الأبطال القدامى –مثل الأنبياء ومن تابعهم- وإتباع هديهم, فهم خير مُحفز, وخير دليل على إمكانية التغيير.
6- زيادة انتماء الإنسان إلى ثقافته ومجتمعه, بمعرفته بتضحيات آباءه.
7- فهم الآخر والتنبؤ بأفعاله, من خلال معرفة تاريخه !
8- مساعدتنا على فهم الواقع, فالتاريخ هو خير مدرسة لتكوين الفرد أو الحاكم الناجح, الذي يستطيع أن يقود عائلته أو أمته بأمان ويجنبها الصدمات والصراعات!
وهناك الكثير من الفوائد الأخرى, سنذكرها في العنصر القادم عند حديثنا عن قصص القرآن.
قصص القرآن
لم يرد في القرآن الكريم كلمة “تاريخ” ولا أي من مشتقاتها, وكذلك في الأحاديث النبوية, وإنما استعمل القرآن مصطلح “القصص”.
ومما يُؤسف له أن هذه الكلمة أصبحت مرادفا للحكايات المختلقة, والتي لا أصل لها في الواقع, وذلك لبعدنا عن بناء حضارة قائمة على القرآن, تستعمل مفردات الكتاب, كما جاءت فيه.
والناظر في القرآن يجد أنه قدّم كثيرا من القصص, والتي تشترك في غاياتها مع التاريخ, إلا أنه لم يقم بالتأريخ! فليس الغرض من الكتاب عرض كل الأحداث التي مر بها البشر مسلسلة, ففي هذا إعادة وتكرار, وفي بعضها الكفاية والغناء!
“وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ …. [النساء: 164]”
لذا فقد اكتفى القرآن العظيم بعرض أهمهما وأعظمها وأحسنها لينتفع بها الناس:
” نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ [يوسف : 3]”
ويختلف القصص القرآني عن التاريخ القائم على الظن في ثبوت الحدث, وعلى احتمال عدم وصوله كاملا للمؤرخ, واحتمال الخطأ في فهم المؤرخ, وعلى احتمال الهوى في عرضه, فيُعرض مدَلسا أو يُخفى بعضه ويُذكر بعضه, وعلى عدم دقة القنوات الإخبارية الناقلة للخبر, لما يعرض للبشر الناقلين من سهو أو نسيان أو لبس أو خلط أو هوى!
يختلف القصص القرآني عن هذا كله في أنه قصص يقيني, قصص حق:
“إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ …. [آل عمران : 62]”
وهو قصص حق لأنه قُص بالحق:
“نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ….. [الكهف : 13]”
وكونه قُص بالحق راجع إلى مزية لا يمكن أن تتوفر بحال لأي مؤرخ على وجه الأرض في أي زمان, -مهما حاز من الوسائل والأدوات- وهي أن القاص كان شاهداً, وهو عالم بالأسباب والمبررات والدوافع!
“فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ [الأعراف : 7]”
فحتى لو كان المؤرخ شاهداً للحدث فهو شاهدٌ غير عالم! فلن يمكن لأي مؤرخ مهما كان أن يطلع على بواطن الأمور, وعلى ما يدور في نفوس الناس وعلى ما يحدث في اجتماعاتهم السرية!
والقرآن العظيم في قصِّه بيّن كيف قص, فلقد قص بالعلم والحق والشهادة, وبيّن ماذا قص, فلقد قصّ حقا ولم يقص افتراء, وبيّن لماذا قصّ.
والآية الأخيرة من سورة يوسف أظهرت عددا من هذه المعاني العظيمة:
“لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [يوسف : 111]”
فالغاية من قصص القرآن:
1- أن يأخذ الناس منها عبرة! ولكن لن يعتبر إلا أولو الألباب, أما عامة الناس فسيرونها قصة مسلية!
2- التفكر, فليس القصص للتسلية:
” …… فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [الأعراف : 176]
3- تثبيت فؤاد المؤمن, عندما يعلم أن من سبقه تعرضوا لما يتعرض له ونصرهم الله في نهاية المطاف:
“وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ … [هود: 120]”
4- الازدجار بمعرفة سوء عاقبة المكذبين:
“وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ [القمر : 4]”
5- معرفة سنن الله تعالى الجارية على عباده, مثل أن الله تعالى يداول الأيام بين الناس: “….. وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ …[آل عمران : 140]”, وأن الأمم تزول بانتشار الظلم والفسق والفساد, وأن سنن الله لا تتحول ولا تتبدل: ” … وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً [فاطر : 43]”,
وأن الأمم لها أجل في هلاكها, وأن أي أمة لا بد أن تُهلك أو تُعذب قبل يوم القيامة –بسبب أعمالها!-
6- هدى ورحمة للمؤمنين بتأكيد الحقائق الإيمانية عندهم, بتذكيرهم بحقيقة الإنسان وبالغاية التي خُلق من أجلها وأن البشرية بدأت بالإيمان ثم كفرت, وأن الأصل في الإنسان التوحيد.
7- تصحيح الأخطاء الواردة في الكتب السابقة, وتصديق الصحيح منها:
“إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [النمل : 76]”
وبعد هذا نسأل:
هل غفل القرآن عن ذكر غاية من غايات التاريخ لم يذكرها صراحة عند حديثه عن القص؟ وهل أتى أو سيأتي علماء التاريخ بأسباب لدراسته لم يسبق إليها القرآن العظيم؟!
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد