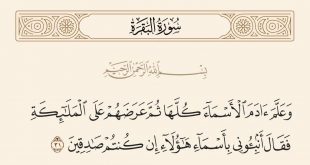المحور العام للسورة:
تناقش هذه السورة قضية من أهم القضايا الإنسانية, وهي قضية حلم القوة والعزة لدى الإنسان, فتبين أن حلم القوة الخارقة لا وجود له في دنيانا هذه, وإنما هي أوهام في أذهان الناس, وليست في العدة والعتاد والتنافس في الحصون, وتبين كيف أن عامة البشر يفشلون في الوصول إلى مصدر القوة الحقيقي, ويقعون في فخ القوة الزائفة المهلكة!
وتقدم له المصدر الحقيقي للقوة الهائلة النافعة وهو “بناء الإنسان”, فإذا استطاع الإنسان أن يبني ويحرر نفسه وغيره من البشر, فبذلك يمتلك قدرة جماعية هائلة نافعة, أما إذا اتجه إلى بناء الأبنية واتخاذ الأتباع فهو بذلك من المضيعين والمهلكين للإنسان.
المنظور العام للسورة:
تبدأ السورة بنفي القسم بأعظم بلد احتوت أعظم بنيان –من الناحية الروحية وهو الكعبة-, وذلك لأن الإنسان (الرسول) مستباح ومستحل فيها من باقي أهل هذا البلد, فليس للبناء مهما عظم مكانة عند الله إذا أهين الإنسان, فحرمة الإنسان عند الله أعظم من حرمة الكعبة, ثم يقسم الله تعالى بالوالد وما ولد (الإنسان), والذان يمثلان أهم مصادر التراحم والتناصر,
أن الإنسان مخلوق في مشقة وشدة معالجة للأمور, ولكن عليه أن لا يعد المكابدات الدنيوية هي مصدر العز والقوة, فيظن أنه بمكابدته وتملكه المال الشديد وانفاقه في المباني العالية والمصارف المختلفة قد حاز السلطة المطلقة, وأصبح يقدر على التصرف في كل ما يحيط به كما يشاء, فما عاد أحد يستطيع التغلب عليه وعلى سلطانه (كما يحدث عند عامة الأباطرة, والذين تصبح مسألة القوة والسيطرة عندهم الدافع الأول وليس المال, فما عاد المال هو الشاغل, فهم ينفقون الأموال الطائلة من أجل الوصول إلى سلطان أكبر وإلى أمان أكثر وإلى تحكم واستعباد أعم للبشر, حتى يظن أنه مختلف عن باقي البشر أو يستحق ما لا يستحقه البشر!) .
فينفض الله عزوجل عنه هذا الوهم نفضا ويذكره أنه إنسان ضعيف يسري عليه كل ما يسري على باقي إخوانه ممن استضعفهم واستباحهم, فيذكره بأنه ليس ذلك الرجل الخفي, وإنما هو إنسان يراه ورأه كل من حوله, إنسان طبيعي يحتاج إلى نعم الله عليه والتي تعينه على المكابدة مثل العين واللسان,
وقديما احتاج إلى ثدي أمه من أجل بناء جسده, فهلا استغل كل ذلك في اقتحام العقبة وإزالتها من أمام من لا يستطيع إزالتها, بأن يحرر الإنسان من ذل العبودية سواء كانت كلية أو جزئية كعبودية الطعام, فيخرج للمجتمع إنسانا حرا نفسا وجسدا يستطيع أن يخدم المجتمع ويساعد في بناءه, وبذلك تقوى وحدة بناء المجتمع عن طريق تحرر عامة أفراده, ولكن قبل أن يحرر غيره يكون ممن حرر نفسه أولا وقواها بالإيمان والعمل الجماعي التابع له, عن طريق التواصي بالصبر وبالمرحمة.
وبهذا يحصل الإنسان على مصدر القوة الحقيقي وهو العائلة الكبيرة المتعاضدة المترابطة التي يساند القوي فيها الضعيف, ويحمله إلى أن يصل إلى ما وصل إليه, لا أن يستعبده. فهذه هي العائلة التي تبني البلد الطيب التي يستحق أن يقسم الله عزوجل به, كائنا أين كان هذا البلد, فالعبرة بالإنسان لا بالبنيان!
ونبدأ في تناول السورة تحليلا, بسم الله الرحمن الرحيم
تبدأ السورة بقوله تعالى “لا أقسم “, ولقد ذكر الله تعالى هذه التركيبة “لا أقسم” ثمان مرات في القرآن, وهناك آراء عدة في فهم هذه التركيبة, وإن كان الرأي الشائع عند عامة المفسرين أن “لا أقسم” تعني: أقسم! و “لا” زائدة!
ولقد وضحنا من قبل في كتابنا “لماذا فسروا القرآن” أنه لا يوجد زيادات في القرآن, وعرضنا لهذه التركيبة وقلنا أن المراد من “لا أقسم” هو “لا أقسم”!
وقلنا لاحقا أن هذه التركيبة تكون عند التعرض لشيء بدهي لا يحتاج إلى القسم عليه, وهنا نضيف: أو مع وجود طارئ يحول دون القسم بالشيء! وهو ما سنراه في هذه السورة.
إذا فالله تعالى يبدأ السورة بقوله “لا أقسم بهذا البلد” والسادة المفسرون مجمعون على أن المراد من البلد هو مكة المكرمة. ونحن نتفق معهم في هذا فلا خلاف في كون البلد المرادة هي مكة.
ومكة بها من الآثار والآيات ما يجعلها تستحق أن يقسم بها, -وخاصة أن الله تعالى قد أقسم بها في سورة التين فقال: وهذا البلد الأمين- فما المبرر هنا لقوله تعالى “لا أقسم”؟
تأتي الآية الثانية فتعطينا هذا المبرر قائلة: “وأنت حِل بهذا البلد”, فهذه الآية هي السبب في عدم الإقسام بمكة, وهي أن النبي الأعظم مستحل مستباح في هذه البلدة من الكافرين, على الرغم من أنهم يحرمون شجرها وطيرها! فإذا ألغي استباحة الرسول أو المؤمن أُقسم بها مرة أخرى.
وعلى الرغم من وضوح لفظة “حِل” إلا أنا وجدنا أن السادة المفسرين قد اختلفوا فيها, فقالوا أنها بمعنى: حال أي مقيم! أو بمعنى: حلال, أي حلال للنبي أن يقتل فيها من يشاء! –وضع ما يحلو لك من علامات التعجب!-, وقيل غير ذلك من الأقوال, وكل هذا التخليط راجع إلى الفهم الخاطئ ل “لا أقسم”, ولو أخذوا كل لفظة على ظاهرها كما هي مقتصرين عليها, لما حصل هذا الخلاف!
إذا فالله تعالى لا يقسم بالبلد الحرام لأن النبي الأكرم مستحل فيها وبها, حيث أن أهل البلد يستحلونه ويستبيحونه (ومن الممكن التوسع والقول أن المراد من البلد هو أي بلدة وأنت: خطاب لكل مؤمن مضطهد من أهل البلد).
ثم يقسم فيقول: “ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد”: اختلف السادة المفسرون في المراد من الوالد وما ولد, فقيل أنه آدم والصالح من أولاده أو آدم وكل البشر أو إبراهيم وأولاده أو إسماعيل وأولاده, ولكن الراجح أن المراد من “ووالد وما ولد” هو الوالد وما ولده من ذكر أو أنثى, ما بلغ منه وما مات في الصغر, وكذلك ما ينجبه الأولاد فهؤلاء مما يعدون مما ولد الوالد, لأنه لا مخصص للفظ.
إذا فالله تعالى يقسم بالوالد وما ولد (والذي منه يتكون البلد) على أنه خلق الإنسان في كبد. والكبد معروف وهو الشدة في معالجة الشيء, وفي هذا يقول ابن فارس في المقاييس:
“الكاف والباء والدال أصلٌ صحيح يدلُّ على شِدّة في شيء وقُوّة. من ذلك الكَبَد، وهي المشقّة. يقال: لَقِيَ فلانٌ من هذا الأمر كَبَداً، أي مشَقة. قال تعالى: لَقَدْ خَلقْنَا الإنسانَ في كَبَدٍ [البلد 4]. وكابدتُ الأمر: قاسيتُه في مشقّة….” اهـ
أي أن الإنسان لا محالة سيواجه العناء والمشقة في حياته كلها, فهناك معالجة أمور حياته من أجل المكسب,
وهناك العلاقات الاجتماعية والتي قد تسبب للإنسان أكبر كبد في حياته من أجل مسايرتها, وهناك الأمراض وهناك المصائب والكوارث وهناك أصناف أخرى من الكبد تعم حياة الإنسان كلها فلا يكاد يخلو منها, ولقد أمده الله بالقدرة على مكابدة كل هذا.
ولايظنن ظان أن هذا قسوة من الله أو عذاب للإنسان وإنما هذا الكبد هو العنصر الأمثل في إخراج أفضل ما لدى الإنسان, وبدونه يترهل الإنسان ويتراخى ولا يبدع, فالكبد هو عنصر التحفيز الأمثل, وسل نفسك هل هناك غني -ماديا- يعيش عيشة الثراء مبدع؟ نادرا ما يكون ذلك,
فالإبداع لا يكون إلا من الفقراء أو متوسطي الحال أو ممن لا يهتم بمسألة المال. والعجيب أن الناس يحاولون أن يبعدوا أنفسهم عن الكبد النافع بأن يتنعموا أو يخلقوا لأنفسهم عوالم من الوهم الناعمة, ولكن هذه العوالم تقودهم لا محالة إلى كبد ضار! فالكبد موجود لا محالة والعبرة بمن يكبد في الخير والنفع.
فإن قيل وما العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه, أي ما العلاقة بين: “ووالد وما ولد” وبين: “لقد خلقنا الإنسان في كبد”؟
قلنا مسبقا: أن المقسم به لا بد أن يحتوي دليلا ظاهرا على صحة المقسم عليه
فإذا نظرنا إلى العلاقة بين الوالد والولد والتي هي أشد العلاقات وأقواها حميمية والتي تعتمد على الحماية والرعاية من جانب لآخر, وجدنا فيها من المكابدة ما فيها, سواء في التربية أوفي التعامل بعد الكبر, فإذا كان الكبد ظاهرا بهذا الشكل بين الوالد والولد فما بالنا بحياة الإنسان كلها والتي يواجه فيها الإنسان ما لا يد له فيه!
إذا فالله تعالى يوضح لنا بالآيات الأربع الأول:
“لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد”
أن الكرامة والعزة عنده ليست للأشياء أو للأماكن, وإنما هي للإنسان بالدرجة الأولى, فالبلد الحرام وإن كان مقدسا ولكنه تزول عنه هيبته إذا أهين فيه أهم من ولد وهو الإنسان الأعظم “محمد بن عبدالله”.
وليست كرامة الإنسان في راحته ورفاهيته وتنعمه, وإنما كرامته في الإقبال على الحياة بالقُدرة التي أعطاه الله إياها, (حتى يحق الحق ويضع الأمور في نصابها)
والعجيب أن الإنسان (لاحظ أن القرآن يستعمل لفظة “الإنسان” في مواطن الذم عند الحديث عن الجوانب الخلقية) بدلا من أن يستغل هذه القدرة التي أعطاها الله عزوجل له في مواطنها, اتجه بها توجها غريبا, فدخله الغرور والكبر,
لذلك قال الله تعالى: “أيحسب أن لن يقدر عليه أحد” رادا ومستنكرا على هذا المتكبر, الذي يظن أنه بلغ من القوة بنفسه وببلده وأهله ما لن يصل إليه غيره, أيحسب هذا الإنسان ألن يقدر عليه أحد؟ فما هو المبرر لهذا الاعتقاد؟
يقول: أهلكت مالا لبدا! , واللبد معروف وهو كما جاء في المقاييس:
“اللام والباء والدال كلمةٌ صحيحة تدلُّ على تكرُّسِ الشَّيءِ بعضِه فوقَ بعض. من ذلك اللِّبْد، وهو معروف. وتلبَّدت الأرضُ، ولبَّدها المطر.وصار النَّاس عليه لُبَداً، إذا تجمَّعوا عليه.
قال الله تعالى: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيهِ لِبَداً [الجن 19]. و لُبَداً أيضاً على وزن فُعَل، من ألبَدَ بالمكان، إذا أقام، والأسدُ ذو لِبْدة، وذلك أنَّ قَطيفَتَه تتلبَّدُ عليه، لكَثْرة الدِّماء التي يَلَغُ فيها. ……..” اهـ
فهذا الإنسان المتكبر الذي يظن أن لن يقدر عليه يتفاخر ببعض قدراته ومبررات عجبه فيقول: أهلكت مالا كثيرا, مشبه كثرته باللبدة وهو الشيء المتكاثف! أي أهلكت مالا لا يستطيع أحدا عده أو الوصول إليه, فأهلكت في البناء وفي الزراعة وفي الحصون وفي الأنعام وفي المتحركات … إلخ! ظانا أنه يستطيع الوصول بالمال إلى كل ما يرغب أو يريد, كأن المال هو القوة السحرية التي تضيف للإنسان أضعافا مضاعفة من القوة وتجعله له القدرة المطلقة!
فيرد الله عزوجل عليه موضحا مساواته للآخرين وعدم تفرده عنهم واحتياجه هو الآخر إلى نفس ما يحتاجه الآخرون, وأن قوته أو ماله لا يغنيان عن هذه الأشياء مقدار ذرة,
فيقول الله تعالى:
“ألم نجعل له عينين” يبصر بهما غيره ويكتشف بهما ما حوله ويتعامل به مع كل ما يظن أن له الغلبة عليه, وكذلك جعل الله عزوجل للآخرين, فهو لم يجعل له فقط, وإنما له ولغيره فلم التكبر والعجب, فماذا لو نزع الله عزوجل منه العينين!
“ولسانا وشفتين” يتكلم بهما ويستخدمهما في تصريف أموره وفي التعامل مع الآخرين, فتصور لو نزع منه القدرة على الكلام, كيف سيكون تعامله مع الناس أعسر وأشق.
والعبرة في ذكر هذه الأعضاء بخلاف غيرها من الأعضاء أنها من أهم أعضاء التواصل مع الآخرين والتحكم فيهم والسيطرة عليهم, فقد يفقد الإنسان يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الداخلية, إلا أنه قد يستغني عن الآخرين وقد يستطيع السيطرة عليهم بنظرات ثاقبة من عينيه وبكلمات حازمة من فيه,
أما إذا فقد هذه الأعضاء فيختفي في الغالب القدرة على التواصل مع الآخرين والتكبر عليهم لأنه يحتاج إليهم في قضاء عامة حاجاته الأساسية فكيف يتكبر عليهم أو يدعي التميز عنهم, وهو في حاجة إليهم دوما.
وبعد هذا الإعداد البدني –والذي لا يختلف فيه عن الآخرين- يذكره الله عزوجل بنعمة أخرى من نعمه عليه وهي: “وهديناه النجدين”, والنجد كما جاء في المقاييس:
“النون والجيم والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على اعتلاءٍ وقوّة وإشراف. ……. وربَّما قالوا في هذا: نُجِدَ فهو منجودٌ. قال:
صادياً يستغيثُ غيرَ مُغاثٍ ولقد كان عُصْرةَ المنجودِويقال: استنجَدْتُه فأنْجَدَني، أي استغثْتُه فأغاثني.
وفي ذلك الباب استعلاءٌ على الخَصم. ومن الباب النَّجود: المشْرِفة من حمر الوَحش. واستنجد فلانٌ: قوِيَ بعدَ ضَعْف. ونَجَدْتُ الرّجُل أنْجُدُه: غلبته. حكاه ابنُ السكِّيت. والنَّجْد ما عَلاَ من الأرض. وأنْجَدَ علا من غَورٍ إلى نجد.ومن الباب: هو نَجدٌ في الحاجة، أي خفيفٌ فيها.
والنِّجَاد: حمائل السَّيف لأنه يعلو العاتِق. والنَّجْد ما نُجِّد به البيتُ من متاع.
والتَّنجيد: التزيين والنَّجْد: الطريقُ العالي. والمنَجَّد الذي نَجَّده الدّهر إذا عَرَف وجَرَّب، كأنَّه شجَّعه وقوّاه.” اهـ
إذا فالنجد أصل يدل على علو وتقوية ومدد, ولقد اختلف السادة المفسرين في النجدين, وإن كان عامة خلافهم يرجع إلى قولين إثنين, وهما: طريقي الخير والشر, أو الثديين! وفي هذا يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره:
“وإلى هذا التأويل ذهب عامة المفسرين في النجدين وهو أنهما سبيلا الخير والشر ،
وعن أبي هريرة أنه عليه السلام قال : « إنما هما النجدان ، نجد الخير ونجد الشر ، ولا يكون نجد الشر ، أحب إلى أحدكم من نجد الخير »
وهذه الآية كالآية في : { هَلْ أتى عَلَى الإنسان } إلى قوله : { فجعلناه سَمِيعاً بَصِيراً إِنَّا هديناه السبيل إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً } [ الإنسان : 1-3 ] وقال الحسن : قال : { أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً } فمن الذي يحاسبني عليه؟ فقيل : الذي قدر على أن يخلق لك هذه الأعضاء قادر على محاسبتك ،
وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ، أنهما الثديان ، ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه ، والله تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضعها” اهـ
والذي نراه أن المراد من النجدين هما الثديان وليس طريقي الخير والشر, فالله تعالى هدى الإنسان إلى طريق واحد, وهو طريق الخير, وإن كان أعطاه القدرة على اختيار الطريق الآخر, ثم إن الطريق غير مشهور بالنجد, حتى إذا أطلق انصرف إليه!
كما أن السياق لا يتناسب بعده. أما إذا قلنا أن المراد من النجدين الثديان, فإن هذا مناسب لكل إنسان, فكل إنسان ولد التقم ثديي أمه بدون مساعدة من أحد, ولا بد أن نذكر أن هذا خطاب في الأساس لإنسان متكبر فلا بد من تذكيره بوجوه حاجاته التي يقر بها,
أما إذا قيل أن المراد من ذلك سبيل الخير والشر, لقال: إنما اهتدي بنفسي إلى الخير واتجنب الشر, أما الثديان فلا يجادل فيهما, كما أن فيهما من الأشارة إلى الضعف والاحتياج ما ليس في غيرهما.
إذا فالله عزوجل أعطى ذلك الإنسان المتكبر العين واللسان والشفاة وهداه وهو صغير إلى ثدي أمه ليرضعه! فلم التكبر والاعتقاد بالصفوية!
ثم يردف الله عزوجل بعد ذلك بقوله: “فلا أقتحم العقبة”, ويمكننا القول أن ما بين قوله تعالى “يقول أهلكت مالا لبدا” وقوله “فلا أقتحم العقبة” معترض, أي أن الله تعالى يخاطب ذلك المتجبر المتكبر بماله حاثا إياه قائلا: فلا أقتحم العقبة! واختلف السادة المفسرون في المراد من قوله تعالى: “فلا “ هل هي تحضيضية, أي بمعنى: هلا اقتحم العقبة! أو هي نافية أي بمعنى: أنه لم يقتحم العقبة!
والذي نرجحه نحن من خلال سياق الآيات القادمة أنها تحضيضية, لأنه إذا قلنا أنها نافية فإنه يكثر معها استعمال التكرار, فنقول: فلا اقتحم العقبة ولا فعل كذا وكذا, كما في قوله تعالى: “فلا صدق ولا صلى”, وهنا ليس ثمة تكرار فيرجح أنها تحضيضية! ولفظ الاقتحام يدل على الدخول بشدة وعنف (وبلا ترو إلى حد ما)! أي فهلا كابد, كما يكابد من أجل التفوق والتميز في الحياة, في العقبة!
واختلف المفسرون في المراد من العقبة, والاختلاف في تحديد لفظ العقبة لازم, لأنها من الكلمات التي استعملها القرآن استعمالا موسعا تجاوز المدلول اللغوي لها, ويدل على ذلك استعمال سبحانه لتركيبة “وما أدراك ما” والتي تدل على عظم هذا الشيء! ولكن هذا لا يعني أن اللغة لا تساعدنا في التوصل إلى المعنى الإجمالي للعقبة! فالعقبة من “عقب” وهي كما جاء في المقاييس:
“العين والقاف والباء أصلانِ صحيحان: أحدُهما يدلُّ على تأخير شيء وإتيانِه بعد غيره. والأصل الآخَر يدلُّ على ارتفاعٍ وشدّة وصُعوبة. فالأوّل قال الخليل: كلُّ شيء يَعقُبُ شيئاً فهو عَقيبُه، كقولك خَلفٍ يَخلف، بمنزلة اللَّيل والنهار إذا مضى أحدُهما عَقَبَ الآخَر. وهما عَقيبانِ، كلُّواحدٍ منهما عَقيبُ صاحبِه. ………….. قال الخليل: عاقبةُ كلِّ شيءٍ: آخره، وكذلك العُقَب، جمع عُقْبة. قال:ويقال: استعقَبَ فلانٌ من فِعلهِ خيراً أو شرَّاً، واستعقَبَ من أمرهِ ندماً، وتَعقَّب أيضاً. وتعقَّبْت ما صنَعَ فلانٌ، أي تتبَّعت أثره. …….. ويقولون: ستَجِد عقِبَ الأمر كخيرٍ أو كشرٍّ، وهو العاقبة.ومن الباب قولهم للرجل المنقطع الكلام: لو كان له عَقِبٌ تكلّم، أي لو كان عنده جواب. ………….. قال الخليل: عَقبت الرّجُل، أي صرت عَقِبَه أعقُبه عَقْبا. ومنه سمِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “العاقب” لأنَّه عَقبَ مَن كان قبلَه من الأنبياء عليهم السلام. …………. قال أبو زيد: جئتُ في عُقب الشهر وعُقْبانِه، أي بعد مُضِيِّه، العينان مضمومتان. قال: وجئت في عَقب الشهر وعُقبه……. قال الخليل: جاء في عَقِب الشهر أي آخرِه؛ وفي عُقْبه، إذا مضى ودخل شيءٌ من الآخر.” اهـ
إذا فالعقب شيء متأخر تابع لغيره, مرتبط بالشدة والعسر, ونحن نستعمل هذه اللفظة في كلامنا اليومي, فنقول: فلان عقبة في طريقي ولا بد من إزاحته! والعقاب ما هو إلا جزاء الأعمال المتأخر الشديد العسير!
فالله سبحانه وتعالى باستعماله هذه اللفظة يشير إلى ذلك المعنى أنه شيء عسير بعيد, ولكن على الإنسان اقتحامه بدلا من الإتيان بالأشياء البسيطة أو التي لا نفع فيها!
إذا فالله تعالى يحس الإنسان ويحضه على اقتحام العقبة ولا يتوقف أمامها عاجزا أو متكاسلا أو مقصرا, فهي أمر عسير بالنسبة له ولكنه يستطيع أن يفعلها, وبذلك يزيل العقبة من أمام من لا يستطيع أن يزيلها. ثم يفخم الله من أمر العقبة فيقول: “وما أدراك ما العقبة”.
وبما أن العقبة لفظ عام قد يدخل تحته الكثير والكثير من الأمور, قام الله عزوجل بتوضيح أهم مظاهر العقبة هذه فقال: “فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة”, وقد يقول قائل: لم “فك الرقبة أو الإطعام” من مظاهر العقبة وليست هي نفسها؟
نقول: عندما تكلم الله عزوجل عن ظن الإنسان الواهم بقدرته ذكر مظهرا من مظاهر القوة والمكنة عند الإنسان وهي قوله “يقول أنفقت مالا لبدا”, فقول الإنسان ليس من عناصر قوته وإنما هو مظهر من مظاهر القوة,
فالاكتساب هو القوة والقدرة, أما الإنفاق فمظهر من مظاهرها. وكذلك فالله عزوجل ذكر هنا فك الرقبة والإطعام وهما أهم مظاهر العقبة ولا مانع من وجود مظاهر أخرى تابعة ومشابهة تندرج ضمنيا تحت العقبة!
إذا فأهم صور اقتحام العقبة هو “فك رقبة” وفك الرقبة معروف وهو تحرير العبيد بأن يشتري عبيدا ويحررهم أو يعتق من لديه أو يكاتبهم, من الممكن أن يدخل فيه كذلك سداد الديون عن المدينين, فيكون بذلك قد فك رقبتهم من السجن!, وكذلك إطعام في يوم ذي مسغبة, والمسغبة من سغب, وهي كما جاء في اللسان:
“سَغِبَ الرجلُ يَسْغَب، وسَغَبَ يَسْغُبُ سَغْباً وسَغَباً وسَغابةً وسُغُوباً ومَسْغَبةً: جاعَ.
والسَّغْبة الجُّوعُ، وقيل: هو الجوعُ مع التَّعَب؛ وربما سُمِّيَ العَطَش سَغَباً، وليس بمُسْتعمَلٍ. ورجلٌ ساغِبٌ لاغِبٌ: ذو مَسْغَبة؛ وسَغِبٌ وسَغْبانُ لَغْبانُ: جَوْعانُ أَوعَطْشانُ.
وقال الفراءُ في قوله تعالى: في يومٍ ذِي مَسْغَبةٍ، أَي مَجاعةٍ.” اهـ
وذكر الله عزوجل هذين الصورتين لأنهما أهم صور استعباد الإنسان, فإذا اقتحمتهما فقد حررت الإنسان, فالإنسان إما أن يستعبد كلية أو يستعبد بلقمة عيشه, فإذا أنا ألغيت هذين العنصرين بأن وفرت للإنسان حريته ووفرت له ما يقتات به حصلت على إنسان سليم معاف مناصر.
وتأتي الآيتان التاليتان فترجح أنهما وآيتي الفك والإطعام من أهم المظاهر وليس المراد بهما الحصر فقط, فتقول: “يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة”, فنلاحظ في هاتين الآيتين استعماله سبحانه وتعالى لحرف العطف “أو” (فك رقبة أو إطعام, يتيما ذا مقربة أو مسكينا), وهذا مرجح لما قلنا به.
أي أن الفك أو الإطعام يزيد فائدته ونفعه إذا كان المفكوك أو المطعوم يتيما ذا قرابة من المطعم أو مسكينا ذا متربة, ومتربة صيغة مفعلة من ترب, وهو تعبير يدل على شدة الحاجة حتى أن التصق بالتراب , والتعبير ب” ذي” يدل على أن هذا حال ملازم له, فهو دوما ذو متربة, لا أن هذا حال عارض. ومبرر نصب “يتيم” هو كونه مفعولا للمصدر “إطعام”.
ونلاحظ في هذه السورة استعماله سبحانه وتعالى لوزن “مفعلة” مرارا, فنجده يقول: “مسغبة, مقربة, متربة, مرحمة, ميمنة, مشئمة”, وفي هذا الاستعمال لطيفة وفارق في المعاني لا يجوز تجاوزه هكذا فنقول: أن مقربة بمعنى قرابة, أو متربة بمعنى تراب! فما اللطيفة في استعمال هذا الوزن؟
إذا نحن بحثنا في اللغة وجدنا أن وزن مفعل يأتي مع اسم الزمان والمكان, ووزن مفعلة يأتي مع اسم الآلة ولكنه يكون بكسر الميم, مثل قولنا: مِغسلة وليس مَغسلة. وقد يصاغ اسم المكان من الأسماء الثلاثية المجردة على وزن مفعلة للدلالة على كثرة الشيء في مكان ما, كما يقال مأسدة وملحمة, في المكان الذي يكثر فيه الأسود أو اللحم (تطايره عند القتال).
إذا فاليوم ذي المسغبة هو اليوم الذي يعم فيه الجوع ويسود (أيام المجاعات), واليتم ذو المقربة هو اليتيم صاحب أسباب القرابة الكثيرة, فهو قريب مكانا –جار- ونسبا وعلاقة وتعاملا مع المعطي! وكذلك المسكين ذو المتربة, والذي اشتهر في فهمه أنه افتقر حتى التصق بالتراب! ولكنا نرى أن المسكين ذا المتربة هو ذلك المسكين الذي يبحث دوما في التراب عما يأكله, فهو يقلب التراب ويثيره دوما عن وبذلك يكون صاحب متربة!
“ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة” أي فهلا اقتحم ذلك الإنسان العقبة وكان بخلاف اقتحامه العقبة من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر: والتواصي بالصبر من أهم عناصر تثبيت الإنسان وإمداده بالقوة, وبدونها قد يضعف الإنسان ويتزلزل من المواقف التي يمر بها, أما إذا وجد من يصبره فيثبت ويُؤتى مددا من القدرة والقوة.
“وتواصوا بالمرحمة” : والمرحمة تحمل معنى زائدا عن الرحمة, فهي لكونها على صيغة مفعلة تحمل في طياتها الرحمة والمرحوم ومحل الرحمة! أي أوصى بعضهم بعضا بالرحمة بكل أشكالها وألوانها, وكذلك بمن يستحقونها وبالأماكن والمواطن التي يُحتاج فيها إلى الرحمة.
“أولئك أصحاب الميمنة” والميمنة من اليمن, ولكنها ليست اليمين كما قال صاحب الكشاف:” الميمنة والمشأمة ، اليمين والشمال ، أو اليمين والشؤم ، أي الميامين على أنفسهم والمشائيم عليها .” اهـ
فهي على وزن مفعلة, وهو من أوزان اسم المكان, فتكون الميمنة محل كثرة اليمن وعمومه وسواده, وهذا يكون في المجتمعات التي تعمل على بناء الإنسان وتحريره, حيث يسود الود والإخاء والتعاضد بين الناس في هذه البلاد.
وأظهر ما يكون محل اليمين هو في اليوم الآخر حيث يقسم الناس إلى أهل يمين فعلا, وأهل شمال, فهؤلاء هم أصحاب الميمنة, -كما يكون هناك ميمنة في الجيش- ومن ثم يصيرون إلى الجنة وهي ميمنة كذلك!
“والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة” والذين كفروا بآيات الله عزوجل ولم يتبعوها, وأصروا على ما هم عليه من الكبر وإهلاك الأموال في ما لا نفع فيه هم أصحاب الشمال ومحل الشؤم في الدنيا, فهم وإن علوا في البنيان إلا أن حياتهم كلها شؤم وضياع لضياع الإنسان, كما نرى في المجتمعات المادية شرقية كانت أو غربية!
ولا تنحصر المشئمة في الدنيا فإن أظهر ما يكون هذا الموقف في اليوم الآخر, حيث يُقسم الناس ويكون هم في ناحية اليسار! ولكن نلاحظ أن الله تعالى لم يقل: “أصحاب الميسرة” كضد للميمنة, كما نستعمل في الجيش, لأن اليسار يحمل معنى البشر والخير والسعة, أما الشأم فهو خلاف اليمين ولكنه يحمل فيه معنى الشؤم والضيق, وهذا ما سيكون عليه أصحاب المشأمة.
لذلك قال الله تعالى في الآية التالية: “عليهم نار مؤصدة“, فهؤلاء بشؤمهم سيكون مرجعهم إلى الشؤم والضيق حيث تحيط بهم النار الضيقة ولا يجدون عنها مصرفا.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم!
 أمر الله خطاب جديد
أمر الله خطاب جديد